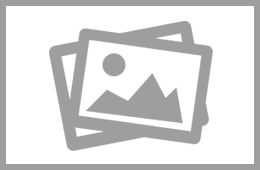مقدمة
ان دراسة الجنسية في ضوء التشريع المغرب, تقتضي في البداية تحديد مفهوم وبيان طبيعتها القانونية
ومن تم ابراز اهم الاحكام التي تقتضي اسنادها واكتسابها وزمالها, هذا بالاضافة الى تحديد المقتضيات
القانونية التي تحكم المنازعات القضائية المتعلقة بها.
I- تحديد مفهوم الجنسية وبيان طبيعتها القانونية
-1 مفهوم الجنسية اللغوي والواقعي :
ان مفهوم الجنسية من حيث اشتقاقه اللغوي أثار خلافا فقهيا بينا, ذلك لان البعض يرى بأن تعبير
الجنسية اذا أمكن اشتقاقه من مصطلح الجنس الذي يفيد السلالة او النوع او العرق فهو تعبير غير
سليم, وذلك من عدة نواحي .
فمن ناحية اولى, أنه تعبير قد ينصرف مدلوله الى عدة معاني, غالبا ما تكون غير محددة, فانه يمكن ان
يدل على الجنس البشري او الحيواني وغيرها من الدلالات التي من الممكن ان لا يدل استعمالها على
ما يمكن ان يؤديه هذا التعبير من المعاني القانونية في اطار القانون الدولي الخاص.
ومن ناحية ثانية, ان التسليم بإتخاد الجنس كمعيار لمنح الجنسية, فيه اشارة الى الاستعلاء والتسامي
العنصري, ومن تم فإن الاخد بهذا المعيار قد يؤدي الى الكراهية والحروب.
اما البعض من الفقه يرى بان الجنسية اذا امكن اشتقاقها من الكملمة الفرنسية nationalité فهو
بدوره اشتقاق غير سليم.
ومن جانب اخر, ان مصطلح nationalité اذا كان ينطبق على ما فيد معناه الحقيقي, في اللغة
الفرنسية, فإنه لا يؤدي نفس المعنى, في اللغة العربية وعلى هذا الاساس حاول الكثير من الففه
العربي ان بيحث عن البديل الا انه لم يصل الى أيه نتيجة على اعتبار انه لا يمكن ان نضفي الصفة
القانونية على مجرد تعبير مادي او لغوي .
ونحن نرى بان الجنسية بمعناها الواقعي او الاجتماعي اذا كانت تقتضي الانتساب, الى شعب او أمة
ما فانه لا يجب أن نأخد بها في مجال القانون الدولي الخاص,
2-مفهوم الجنسية من الناحية القانونية :
اختلف الفقه في التحديد القانوني لمفهوم الجنسية اختلافا بينا وذلك بسبب اختلاف وجهات نظرهم,
حول ما إذا امكن اعتبار هذا المفهومات طبيعية مزدوجة قانونية وسياسية قي ان واحد او ذات
طبيعة قانونية محضة.
فالفقه الذي ينظر الى مفهوم الجنسية بالمنظور الاول يعتبر بأن الجنسية هي رابطة قانونية, وسياسية
تفيد اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة, او هي رابطة قانونية
وسياسية تنشئها الدولة بقرار منها فتجعل الفرد تابع لها.
ومن جانب أخر, عرف بعض الفهاء الجنسية من منظرورقانوني باعتبارها الانتماء القانوني لشخص
معين تجاه الشعب المكون لدولة معينة, اوانها رابطة تجمع الفرد بدولة ذات سيادة هو قانون من رعاياها .
او هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة, يصير الفرد فيها بمقتضاها عضوا في شعب الدولة.
رابطة بين الفرد والدولة تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها
الذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية وتبرزها امة بملامحها التي تميزها عن
غيرها من الأمم متحدةً في اللغة والجنس والعادات والرغائب والمصير المشترك .
يتبين مما سبق اختلافات الفقهاء حول مفهوم وتعريف الجنسية لم تكن اختلافات جوهرية بقدر ما كانت
اختلافات حول توضيح وتوسيع مفهوم هذه الجنسية ولهذا فانهم اجمعوا على انها رابطة أو علاقة بين
شخص ودولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من
كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولة المنشئة
والمنظمة لها .
3-مبـــادى الجنسيــة
*مبدأ حرية الدولة في اسناد الجنسية
مضمون هذا المبدأ هو انه يحق لكل دولة, ان تعين بواسطة تشريعها من هم مواطنوها ومن هم
الاجانب, وذلك من خلال تنظيم الجنسية, وهذا ما أقرته المادة الاولى من اتقافية لاهاي الموقعة
في 12 ابريل1930 بشأن بعض المسائل المتعلقة بتنازع القوانين حول الجنسية.
ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات المستمدة من المعاهدات المبرمة, بين الدول لسيما اذا كانت هذه
المعاهدات تفرض قيودا, على الدول التي أنشاتها بخصوص تنظيم الجنسية, او شروط منحها, ففي هذه
الحالة, نتعدم حرية الدول, في اسناد جنسيتها وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى, من
ظهير الجنسية المغربية حيث اعتبرت بأن مقتضيات المعاهدات او المواثيق الدولية المصادق عليها,
والمرافق على نشرها, ترجح على أحكام القانون الداخلي.
*مبدأ احقية الشخص في الجنسية او التجنيس :
هذا المبدأ اقر بدوره من طرف المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الانسان او المعاهدات الدولية,
التي ابرمت بشأن توحيد قواعد القانون الدولي الخاص.
فالنسبة للمواثيق فقد أكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فصله الخامس عشر "ان لكل فرد حق
التمتع بجنسية ما, وأنه لا يجوز حرمانه من جنسيته بطريق التحكيم او انكار حقه في تغيير الجنسية"
اما بالنسبة للمعاهدات الدولية المبرمة بشأن توحيد قواعد القانون الدولي الخاص, فقد اكدت اتفاقية
لاهاي المذكورة أنفا في ديباجتها الاولى على "أن من المصلحة العامة للجماعة الدولية العمل على
تسليم كافة اعضائها بأن لكل فرد يجب ان تكون له جنسية وألا تكون له إلا جنسية واحدة, وان المثل
الاعلى الذي يجب أن نتجه اليه الانسانية في هذا الخصوص هو القضاء على حالات انعدام
الجنسية وتعددها" .
يفهم من النصوص السابقة الذكر, بأن الاستفادة من الحماية الدبلوماسية او غيرها من الحقوق التي
تترتب على الجنسية الاصلية, او المكتسبة يجب ان يمتد نطاقها ايضا حتى الى عديمي الجنسية او الى
من لا أب لهم بإعتبار ان الجنسية أصبحت حقا من حقوق الانسان الاساسية, يستطيع اي واحد من
هؤلاء ان يتمتع بها, وهذا ما أكده المشرع المغربي عندما لم يميز بين الابناء الشرعيين, وغير
الشرعيين في التمتع بالجنسية الاصلية.
وكما يفهم أيضا, بأنه لا يجوز لأي دولة ان تجرد رعايها من جنسيتهم ولو كان ذلك بناء على طلبهم.
إلا ما ورد بشأنه نص خاص, كما في حالة ارتكاب الجرائم التي تمس بأمن الدولة الخارجية المنصوص
عليها في القانون الجنائي المغربي.
4-خصـائـص الجنسيـة وتنظيمها القانوني
الجنسية بإعتبارها مؤسسة قانونية تمتاز بخاصيتين اساسيتين يمكن حصر احدهما في كون انها صفة
تندمج في ذات الفرد الذي يتمتع بها, ويمكن حصر ثانيها في كون انها أداة توزيع الافراد بين الدول .
*خ1-الجنسية صفة تندمج في ذات الفرد
المقصود من هذه الميزة ان الشخص الذي يحصل على جنسية الدولة التي ينتمي اليها, كجنسية
أصلية او مكتسبة, يصبح متمتعا بهذه الجنسية, باعتبارها صفة تندمج في ذاته, بصفة مطلقة, بحيث لا
يمكن لأحدهما رفع هذه الصفة عن الاخر, إلا بنص في القانون, وهذا ما يفسر بأنها تنتقل من السلف
الى الخلف, وذلك رغما عن الدولة والفرد معا لتلازمها من حيث الوجود والعدم.
ويفهم من هذه الميزة ان الجنسية هي صفة فردية تخص الشخص الذي يتمتع بها فقط وذلك انطلاقا
من شخصيته القانونية التي تخول له هذه الجنسية كفرد وليس كجماعة وهذا ما توضحه الفصول
المتعلقة بالاثارالمترتبة عن اكتساب الجنسية بحكم القانون او التجنس, وذلك لأن هذه الفصول توضح
بان الفرد في حالة تمتعة بهذه الجنسية لا يستفيد منها, الا بصفته فردا, لا بصفته جمعا, لانه هو وحده
الذي يتمتع بالشخصية القانونية, ومن ثم فإن قواعد قانون الجنسية, تخاطبه بهذه الصفة سواء تعلق
الامر بسحب وثيقة هذه الجنسية او استرجاعها او التخلي عنها, او التجريد منها الا ما قرره
بنص خاص.
*خ2-الجنسية أداة توزيع الافراد بين الدول :
ان هذه الميزة جعلتنا نؤكد على ان الجنسية لا ترتبط بالامة كظاهرة اجتماعية وانما ترتبط بالدولة
كظاهرة سياسية وهذا يعني امرين اساسين :
-ويفيد بأن الدولة لا يمكن ان تقوم بتنظيم الجنسية, الا اذا كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية,
وهذا ما جعل من الفقه أن يجمع على ان الدول التي تتكون منها الفدرالية, لا تستطيع ان تختص بهذا
التنظيم, لإنعدام تمتعها بهذه الشخصية فإن من حقها ان تنظم الجنسية, حتى ولو كانت أقل حجما او
ضيق رقعة او أقل السكان عددا كإمارة موناكو جنوب فرنسا.
وينبني على هذا التمييز انه لا يشترط في هذا التنظيم وجوب الاعتراف بالحكومة القائمة في الدولة
التي تختص بهذا التنظيم لان عدم الاعتراف بهذه الحكومة لا يؤثر في ثبوت الشخصية الدولية, للدولة
التي تنتمي اليها هذه لحكومة غير المعترف بها بعد .
-لامر التالي ويفيد بأن التنظيم الجنسية, اذا كان يرتبط بسيادة الدولة التي لها وحدها حق هذا التنظيم,
فان هذه السيادة, لا ينحصر نطاقها في الاقليم فقط وانما يمتد الى خارج الاقليم, وذلك من خلال افرادها
الذين لا يخضعون الا الى قانون الدولة التي يتمتعون بجنسيتها بإعتباره مظهرا من مظاهر سيادة هذه
الدولةذ, او من خلال بعض الاشياء المادية التي تتجسد فيها هذه السيادة كالسفن والطائرات.
ومن جانب أخر, ان الجنسية اذا كانت تشكل الاداة الوحيدة للتمييز بين المواطنين والاجانب, انطلاقا من
هويتهم الوطنية او الدولية التي تحددها لهم هذه المؤسسة القانونية, فإن الذي يميز السفن والطائرات
هو علم الدولة التي قيدت في سجلاتها, وليس جنسيتها.
5-تننظيــم الجنسيــة
ان تنظيم الجنسية من طرف طرف كل دولة, يقتضي مراعاة نقطتيم اساسيتين تتعلق احداهما بتنظيره
وتتعلق ثانيها بالمشكلات التي يمكن ان يثيرها هذا التنظير.
1/تنظير تنظيم الجنسية
ان نتظير تنظيم الجنسية ظل يثير خلافا فقهيا, بخصوص موقع هذا التنظيم من فروع القانون المختلفة
من جهة ومراعاة قواعده, وخصوصياته من جهة أخرى.
*موقع تنظيم الجنسية من فروع القانون :
فالبنسبة لموقع تنظيم الجنسية, وقع بشأنه خلاف فقهي, ما إذا أمكن اعتبار هذا التنظيم يخضع في
تنظيره الى فروع القانون العام او فروع القانون الخاص.
هناك من الفقه يرى بوجود صلة بين الجنسية وفروع القانون العام, التي يعكسها القانون الدستوري
والقانون الاداري. فالقانون الدستوري هو القانون الاساسي والاول الذي يضع القواعد العامة
للجنسية, بإعتباره وحده الذي ينظم عنصر الشعب, وثم فهو الذي يقرر حق الدولة في تنظيم هذه
المؤسسة القانونية وفق قوانينها الداخلية او المعاهدات الدولية االمنظمة لها.
-يعتمد هذا الرأي في بيان الصلة بين الجنسية والقانون الدستوري في كونه يميز بين المظفيين
الوطنيين والاجانب من خلال بيان الحقوق المخولة لهؤلاء الوطنيين دون من هم ليسوا كذلك, كحق
الانتخاب والترشيح, وحق تولي الوظائف وحق تولي الوظائف وحق الحصول على حماية الدولة, و
القيام بالخدمات العسكرية والدجفاع عن الوطن.
-اما بالنسبة لصلة الجنسية بالقانون الاداري, فقد حصرها الفقه في اختصاص احدى اجهزة السلطة
التنفيدية في تلقي التصريحات او الطلبات المتعلقة باكتسباب الجنسية بحكم القانون او التجنيس
والبث فيها بقبول او الرفض, ونفس االشيىء في طلبات التخلي عن الجنسية او التجريد منها .
اذا اخدنا بعين الاعتبار هذا التوجه الفقي السالف الذكر, فهو مرفوض من عدة نواحي, الناحية الاولى
انه ليس من الممكن التسليم بان الجنسية يقع تنظيمها في اطار فروع القانون العام, انطلاقا من كون
هذه الفروع اشارت الى بعض قراعدها او الاحكام المرتبطة بها, لان مثل هذه القوانين لها ميزت وضع
القواعد العامة لكل القوانين وذلك بغض النظر عن طبيعتها من فروع القانون العام او القانون
الخاص وليس لقانون الجنسية فقط.
-أما الناحية الثانية فالتمييز بين فروع القانون العام او القانون الخاص هو تمييز شكلي, وبذلك فهو
ليس له اي تأثير على طبيعة الموضوع الذي يمتاز به كل قانون, تقوم الدولة بتصديره, في نطاق محدد
هذا بالاضافة الى أنه يستحيل انكار العلاقة القائمة بين مختلف القوانين ذلك اما مراعاة لاخضاعها الى
نفس المسطرة, او تكون موضوعها يتكرر حسب موقعه, او اهميته من هذه القوانين.
ولكن رغم كل هذه الانتقادات فقد اصر بعض الفقه الاخر على ان يعتبر الجنسية هي من فرع من فروع
القانون الجنائي، وذلك نظرا لما له من صلة بهذه الفروع وبصفة خاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي
ومدونة الاسرة .
-فالبنسبة للقانون الجنائي اعتبر هذا الفقه بأنه يأخد الجنسية بعين الاعتبار في كثير من الحالات
وبصفة خاصة, في الحالات التي تتعلق بتسليم المجرمين, لأن الدولة كيفما كانت ترفض ان تسلم
مواطنيها لدولة اخرى من أجا متابعنهم, في القضايا التي تعتبرها جرائم ارتكبها هؤلاء في حقها .
لقد اصبح من المسلم به في اطار الاتفاقيات الدولية, عدم تسليم المجرمين الى الدولة التي يحملون
جنسيتها في الجرائم السياسية المرتكبة ضدها الا في اطار الاتفاقيات المبرمة بين هذه الدول.
يؤكد انصار هذا الاتجاه ان الجنسية تلعب دورا اساسيا في نطاق القانون الجنائي وبصفة خاصة, في
جرائم أمن الدولة المرتبطة بالخيانة او التجنيس ذلك لأن هذه الجرائم في بعض الحالات تعتمد فيها
المتابعة في تحديدجنسية الشخص ما اذا كان وطنيا او أجنبيا وذلك اما بتحديد العقوبة او امكانية
تجريده من الجنسية وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في المجموعة الجنائية ظهير 6شتنبر1958.
-اما بالنسبة لمدونة الاسرة فيبدوا بأن هناك تداخل واضح بين هذه المدونة وقانون الجنسية, وهذا
التداخل تؤكد عليه المادة الثانية من هذه المدونة والفصل الثالث من الظهير السالف الذكر.
ومن تطبيقات هذا التداخل ان الجنسية الاصلية المؤسسة على الرابطة الدموية من جهة الاب, لا يمكن
ان تقوم إلا بناء على صحة النسب, الذي يحدده أحكام قواعده قانون الاسرة او الاحوال الشخصية.
لكن بالرغم من هذه العلاقة بين قوانين الجنسية, وغيرها من فروع القانون الخاص, إلا أن هذه
القوانين لا تعني بأن تنظيمها يفسر بأنه فرع هذه الفروع وذلك راجع لنفس الانتقادات التي سبق ذكرها .
ومن جهة أخرى ان قانون الجنسية ليس هو لا فرع من فروع القانون الخاص, ولا من فروع
القانون العام, وذلك لما سيتم به من ذاتيته وطبيعته خاصة تفسرها الخصائص التي سبق بيانها.
*مراعاة القواعد المتبعة في تنظيم الجنسية
لقد حصر القواعد التي يجب مراعاتها عند تنظيم الجنسية, في ثلاتة أنواع رئيسية ترتبط إحداهما
بالواقعية وثانيها بالمصلحة الوطنية وثالثها بحقوق الانسان.
القاعدة الاولى : مراعاة الواقعية
اذا سلمنا بميدأ حرية كل دولة, في تنظيم جنسيتها فان هذا المبدأ من الصعب أن يجد الاساس الذي
يقوم عليه, دون أن يصطدم مع إرادات الدول الاخرى, التي قد تعارض أو توافق على النتائج التي
ينتهي اليها هذا التنظيم, وهذا ما يؤكد, بأن هذا التوافق هو الذي يكون أساس او مصدر تنظيم كل
دولة لجنسيتها, دون أي تدخل من طرف البعض ضد البعض الاخر.
ومنه جاء تأصيل المادة الاولى من اتفاقية أبريل 1930 التي نصت على أن لكل دولة ان تحدد
بمقتضى تشريعها من هم مواطنوها, وهذا التشريع يجب أن ترتضيه الدولة الاخرى.
نستخلص من هذه المادة بأنه لا يمكن ان تتحدد قواعد تنظيم قواعد الجنسية بين الدول المتعاقدة, دون
مراعاة حق الدول الاخرى, في هذا التنظيم الامر الذي يجعل من هذه المؤسسة القانونية, أداة تنازع
القوانين من جهة. ومن جهة أخرى أنه لابد أن يكون هناك توافق بين الدول المختلفة, في عدم
المساس بأي تنظيم للجنسية, بالنسبة لدولة أخرى كمنع التخلي عنها في حالة وجود رغبة لدى الافراد
في هذا التخلي, او التجريد منها مراعاة ما اذا كان هذا التجريد الذي وقع في حقه يبقى عديم الجنسية.
ويبدوا مبدأ الواقعية واضحا, في تنظيم الجنسية في كل ما يتعلق بموضوع هذه الجنسية, سواء تعلق
الامر بمنحها او إكتسابها او التخلي عنها او التجريد منها, وذلك وفق شروط تجد اساسها في هذا
المبدأ وليس في شيء أخر.
وبمعنى أخر ان تنظيم الجنسية لا تعتمد فيه الدولة, على منظوماتها القانونية لتحديد موضوعية, كالحالة
المدنية, او قانون الاسرة او غيرهما من القوانين, وإنما تعتمد فيه على اعتبارات تجد أساسها في
الواقع وليس في القانون.
ويمكن ان نخلص من هذه القاعدة الى القول بأن الانتماء الواقعي لأي شخص الى دولة معينة لا يعبر
عن جنسية هذا الشخص بقدر الشخص بقدر ما هو يراعى عند تنظيم جنسية الدولة التي يتمتع بها فقط.
القاعدة التانية : مراعاة المصلحة الوطنية
ينصرف مفهوم المصلحة الوطنية الى كل ما يتعلق بالامن والاقتصاد والتكاثر الطبيعي للسكان,
فالبسبة للمصلحة المتعلقة بالامن, لا يمكن للدولة ان تسمح عند تنظيم جنسيتها بالتمتع بهذه الجنسية
لأشخاص ممن هم يشكلون خطرا على مصالحها العليا. كما لا يمكن ان تسمح بنفس التنظيم اذا كان لا
يتلائم مع الزيادة السكانية التي تخطط لها الدولة من جهة او يساهم في الرفع من عدد العاطلين
او الفقراء في شعبها من جهة أخرى.
القاعدة الثالثة : مراعاة حقوق الانسان
تقتضي هذه القاعدة بان الجنسية هي صفة تندمج في ذات الفرد, ومن خلال هذا الاندماج, فان
الجنسية أصبحت تعتبر بكونها من أهم حقوق الانسان وعلى هذا الاساس يحب مراعاة هذا الاعتبار
عند تنظيم احكامها, وهذا ما جعل المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان تقضي بأن
لكل فرد الحق في التمتع بالجنسية ومن ثم فإن لا يجون حرمانه منها, او الانكار عليه حق تغييرها.
ومنه يمنع على أي دولة عند تنظيم جنسيتها ان تحرم رعاياها من جنسياتهم من جهة او تمنعهم من جهة
أخرى, فمن حيث منعها من رفع صفة الجنسية عليهم يندمجون فيها كليا, وهذا ما يفسر بأنه في حالة
تجريدهم منها لابد من مراعاة اذا كان هذا التجريد يؤثر او لا يؤثر في الحيلولة دون ان يصبحوا
عديمي الجنسية.
اما من حيث عدم منعهم من تغييرها, فذلك ما يتراءى في اعتراف الدولة باللجوء الى هذا الحق,
في بعض الحالات وهذا النهج اتبعته معظم الدول, في الوقت الحاضر وذلك اقتداءا بما نصت عليه
المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويعتبر المشرع المغربي من بين الدول التي اعترفت
بهذا الحق في الف19 من ظهير 6شتنبر1958.
-اما بالنسبة لمدونة الاسرة فيبدوا بأن هناك تداخل واضح بين هذه المدونة وقانون الجنسية, وهذا التداخل تؤكد عليه
المادة الثانية من هذه المدونة والفصل الثالث من الظهير السالف الذكر.
ومن تطبيقات هذا التداخل ان الجنسية الاصلية المؤسسة على الرابطة الدموية من جهة الاب, لا يمكن ان تقوم إلا بناء
على صحة النسب, الذي يحدده أحكام قواعده قانون الاسرة او الاحوال الشخصية.
لكن بالرغم من هذه العلاقة بين قوانين الجنسية, وغيرها من فروع القانون الخاص, إلا أن هذه القوانين لا تعني بأن
تنظيمها يفسر بأنه فرع هذه الفروع وذلك راجع لنفس الانتقادات التي سبق ذكرها .
ومن جهة أخرى ان قانون الجنسية ليس هو لا فرع من فروع القانون الخاص, ولا من فروع القانون العام, وذلك لما
سيتم به من ذاتيته وطبيعته خاصة تفسرها الخصائص التي سبق بيانها.
*الطبيعة القانونية للجنسية
لقد وقع خلاف حول تحديد طبيعة الجنسية, ما اذا كانت هذه الطبيعة تنضوي تحت رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة او
هي رابطة قانونية.
1-الجنسية رابطة عقدية :
ارتبطت هده النظرية بفترة ازدهار الفكر اللبرالي الذي كان ينظر الى الارادة الفردية ننظرة قدسية. ومقتضى هذه
النظرية هو ان الجنسية تنشأ بسبب وجود مواقف بين ارادتي الدولة, والفرد, وذلك بهدف حصول هذا الامر على
حماية قانونية سواء في الداخل او الخارج, مقابل ما يتعهد به إزاء الدولة التي تعاقد معها ببذل كل جهده في تمويلها
بالضرائب او الموت في سبيلها في حالة الاعتداء عليها.
وكانت هذه النظرية تجد اساسها في نظرية العقد لاجتماعي التي كانت سائدة في القرن 18 بحيث يمكن للدولة وفق
هذا التصور من القيام بإصدار قواعد قانونبة تنظم ما تقتضيه ارادتها فيما يتعلق بطريق منح الجنسية, او اسنادها
او طريقة موافقتها على الطلب الذي يتقدم به الشخص الراغب في اكتسابها عن طريق التجنيس.وتقوم بتنظيم الجانب
المتعلق بالافراد الذين يعلنون عن ارادتهم في اكتساب هذه الجنسية.
لكن هذه أصبحت مهجورة في نظر البعض وذلك راجع الى سببين :
س1-يتمثل في كون توافق ارادتي الدولة والفرد, لا وجود له من الناحية العلمية في ما يخص الجنسية الاصلية
على اعتبار أن الفرد في هذه الحالة تفرض عليه الدولة جنسيتها فرضا بمجرد قيام الرابطة الدموية او الترابية.
س2-ان الاستجابة الى رغبة الفرد في حالة طلبه للحصول على الجنسية تتوقف في جميع الاحوال على السلطة
التقديرية للجهة المختصة في الدولة بمنح هذه الجنسية او رفضها بل ويمكن لهذه السلطة ان تنزع الجنسية ممن
سبق ان منحته له.
ويتضح مما سبق ان النظرية القائلة باعتبار الجنسية رابطة عقدية لا تزال قائمة, وبصفة خاصة ما يتعلق بالاحكام
المنظمة للتجنيس, دون الاحكام المنظمة او المتعلقة بالجنسية الاصلة, او الجنسية المكتسبة بحكم القانون, وبهذا
يمكن لكل من الدولة والفرد ان ينهي العقد القائم بينهما بزوال الجنسية او بسحبها من جانب واحد ولهذا السبب
فليس هناك ما يمنع من أن تكون الجنسية رابطة عقدية وقانونية في وقت واحد.
2-الجنسية رابطة قانونية
يذهب أنصار هذه النظرية الى القول بأن الجنسية تدخل في نطاق انفراد الدولة بتنظيم احدى مكوناتها الاساسية وهو
مكون الشعب على اعتبار أنها هي الوسيلة الوحيدة للتميز بين السكان الوطنيين وبين الاجانب ولكن هؤلاء في طبيعة
تكييف هذا التنظيم ما إذا كان يلزم ان يخضع الى القانون الخاص, ام الى القانون العام, وذلك بالشكل الذي وقع فيه
الخلاف حول تكييف القانون الدولي الخاص .
-فالفريق الذي ينظر الى الجنسية بمنظور اعتبارها رابطة قانونية فهو يخضع احكامها الى قواعد القانون الخاص,
وذلك استنادا الى كون هذه الاحكام تتعلق بالحالة المدنية للفرد, او أن الاثار المترتبة عنها بنطاق هذه القواعد على
أساس ان تحديد جنسية هو الذي يسهل من التعرف على القانون الواجب تطبيقه في مجال الاحوال الشخصية.
-اما الفريق الذي ينظر الى الجنسية من منظور اعتبارها رابطة تنظيمية, وذلك استنادا الى الطبيعة الازدواجية في هذه
الرابطة من كونها رابطة قانونية, وسياسية في وقت واحد, فهو يخضع احكامها الى قواعد القانون العام, لا الى
القانون الخاص, على أساس ان التمييز هو الذي يجعل من هذه الدولة ان تملك الحق في تنظيم القواعد المنظمة
للجنسية, او هي تشكل المصدر الوحيد لمنحها او اسنادها, بل وحتى في الحالة التي تكون فيها خمصا, او مدعى
عليه في القضايا هذه الجنسية تكون ممثلة بهيئة النيابة العامة .
لقد ايد القضاء المغربي هذا الموقف الفقهي, عندما اعتبر بأن "الجنيبة مظهر من مظاهر السيادة الدولية, وأن
تصريح القضاء بإنتساب شخص ما الى جنسية بلد أخر, يكون مساسا بسيادة ذلك البلد الذي يختص وحده بالاعتراف
بجنسيتة لذلك الشخص او انكارها عليه.
ومن جهة اخرى ان الدولة أصبحت في الوقت الحاضر, تهتم بتنظيم جميع أحكام قواعد القانون سواء كانت خاصة
او عامة, ولذلك فليس هناك ما يمنع من انفراد الدولة بتنظيم هذه الاحكام, في نطاق قواعد الجنسية ولكن من دون
القوا بأن الجنسية هي رابطة قانونية,او سياسية وذلك انطلاقا من اعتبارها مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.
وبناء على هذه الانتقادات, فان الجنسية ذات طبيعة مزدوجة وذلك من حيث اعتبارها رابطة عقدية وقانونية في نفس
الوقت. فهي رابطة رابطة عقدية, لان الفرد في بعض الحالات هو الذي يعرض على الدولة ايجابه بإكتساب جنسيتها
او التخلي عنها .
وهي رابطة قانونية, لأن الدولة وحدها هي التي تتكفل بتنظيم الاحكام المتعلقة بها, سواء في حالة اسنادها كجنسية
اصلية او في حالة سحبها, او منعها اواسترجاعها كجنسية مكتسبة.