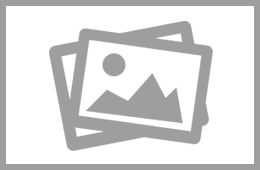استطاعت هذه المواثيق في أن تفرض نفسها كمرجعية أساسية لإقرار الحريات العامة و دسترتها في العديد من دول العالم في القرن 19 و 20 بالاضافة لمساهتمها في تدويل نظمومة الحقوق و الحريات .
إصدار منظمة الامم المتحدة لإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 و قد تم اغناء هذه الوثيقة بوثيقتي العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية كلاهما سنة 1966 و تشكل الوثائق المذكورة هرم القانون الدولي لحقوق الانسان كما تمثل المرجعية القانونية و الروحية العليا للمواثيق الدولية و الاقليمية لحقوق الانسان و الحريات العامة ذات الالتزام الاقانوني ، بالإضافة إلى الاعتراف بمبادئها في جل الدساتير الوطنية عبر العالم .
الاتفاقية الاوربية و الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان
الاتفاقية الاوربية : ايمانا منهم بتقارب الحضاري و الميراث المشترك التاريخي و الثقافي و سيادة القانون ، و المصير المشترك تم التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 1950 و ذخلت حيز التنفيد سنة 1953 ، شملت عدة حقوق مثل الحق في الحياة و الامن ، الاعتراف بالخصوصية الفردية و الفكر و العقيدة و نجد أن مجمل الحقوق مستمدة من أفكار الفلاسفة و المنظرين السابقين ، إضافة إلى التأثر بمبادئ الثورة الفرنسية .
الجديد في الاتفاقية تم التنصيص على بعض الاجهزة لحماية حقوق الانسان خلافا للاعلان العالمي لحقوق الانسان و هي :
اللجنة الاوربية لحقوق الانسان : مهمتها تلقي الشكاوى التي تطال حرية الانسان و حقوقه خاصة في الدول الاعضاء ثم يقوم هذا الجهاز بعرضها على أنظار المحكمة الاروبية لحقوق الانسان.
المحكمة الاوربية لحقوق الانسان : تتكون من عدة قضاة ينظرون في القضايا المرفوعة اليهم بعد محاولات فشل اللجنة و أحكامها نهائية و ملزمة ثم ترسل الى لجنة الوزراء قصد التنفيد.
لجنة الوزراء : جهاز سياسي مهمته اختيار أعضاء اللجنة و مهمته النظر في خرق الاتفاقية .
الامين العام للمجلس الاوربي : جهاز إضافي مهمته مساعدة المجلس الاوربي في أداء وظيفته .
الاتفاقية الامريكية : تم التوقيع عليها سنة 1969 و ذخلت حيز التنفيد سنة 1978 اكدت على احترام الحرية الشخصية و العدالة الاجتماعية و احترام حقوق الانسان كما نصت على مجموعة من الحريات مثل المشاركة السياسية في المناصب العامة و غيرها و قد أنشأت كذلك لجان للمحافظة على هذه الحريات أهمها اللجنة الامريكية لحقوق الانسان و المحكمة الامريكية لحقوق الانسان.
الحريات العامة من خلال بعض مؤسسات الدولة غير الرسمية :
منظمة العفو الدولية و الحريات العامة : أسست سنة 1961 في لندن و تنشط في أزيد من 40 دولة و العالم مهمتها الدفاع عن السجناء السياسيين و سجناء الرأي و المعتقد يناضل من أجل الغاء عقوبة الاعدام و العقوبات الوحشية و المهينة لحقوق الانسان و لها سلطة معنوية و أدبية من خلال تعبئة الرأي العالمي بالمؤتمرات و المنشورات و البايانات و التقارير السنوية .
المنظمة الدولية للحقوقيين أو اللجنة الدولية للحقوقيين : تأسست سنة 1952 دورها إرساء مبادئ العدالة والمساواة و حماية حريات الانسان إحتراما للقانون و المشروعية و تمارس سلطتها من خلال الاستشارات التي تقدمها للهيئات الدولية إضافة الى هذه المظمة هناك العديد من الاتفاقيات المكملة لما سبق مثل : تلك المتعلقة بحماية فئات و منع الابادة الجماعية و الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز العرقي زد على دلك الاتفاقيات الاقليمية كإعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام ثم الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادق عليه مجلس جامعة الدول العربية سنة 1994 و الذي يدعو إلى انتخاب لجنة خبراء حقوقيين من اجل إحالة جميع التقارير عليها.
ما قبل الحماية
لم تعرف الاوساط السياسية في هذه المرحلة جدلية السلطة و الحرية كون التنظيم المجتمعي في تلك الفترة يقوم على الجماعة و القبلية و تحكمه الاعراف و التقالييد .
في بداية القرن 20 علت بعض الاصوات ذاخل النخب المغربية من أجل بناء نظام دستوري بمؤسس للحريات و كان أبرزها مشروع دستور علي زنبير لسنة 1904 ثم مشروع دستور 1908 الدي طالب بملكية دستورية و تضمن ثلات ابواب من بينها باب لحقوق المواطنين و واجباتهم : الحريات العامة في العمل و القول ،تأمين المواطنين على حريتهم الشخصية ، كحرمة المسكن و حرية الاقامة و منع التعذيب و عدم مشروعية كل عقوبة لا يقرها القانون ، و جعل عقوبة الاعدام و العقوبات الشاقة من اختصاص منتدى الشورى ، كما تضمن المشروع المساواة في الحصول على الوظيفة ، و إلزامية التعليم الابتدائي و إحترام حق الملكية .
لم ترى هذه المشاريع النور بسبب العداء الخفي و مقاومة هذه المشاريع من طرف السلطان عبد الحفيظ و حقق المستعمر أطماعه بإخضاع المغرب للحماية.
فترة الحماية
المطالبة بإستقلال الدولة كان لصيقا بالمطالبة بالحرية ، حرية الدولة و الافراد من المستعمر الفرنسي ، تمحورت المطالبة بالإصلاح في إطار الحماية حول برنامج المطالب الذي تمخض عن كثلة العمل الوطني سنة 1934 و تم تقديم عريضة للملك و الاقامة العامة تتضمن جملة من الحريات ، كوضع حد للتمييز العنصري ، و تكوين كجمعيات و الحق في التظاهر و الصحافة و حرية العمل السياسي و منع الاعتقالات.
بالرغم من إصدار ظهائر خاصة ظهير 1936 بشأن تنظيم المظاهرات الا ان سلطات الاستعمار منعت المغاربة من ممارسة هذه الحقوق.
بعد الاستقلال :
يعتبر العهد الملكي الصادر سنة 1958 لبنته الاولى لإقرار مبدأ الحريات العامة حيث سعى لتحرير المواطن بعد تحرير البلاد و هذا المبدأ سيذكر في" القانون الاساسي للملكة الصادر 1961" و احتفظت به جميع الدساتير المغربية ، و بصدور قانون الحريات العامة في نفس السنة أي 58 الذي تضمن 3 ظهائر الاول يتعلق بتأسيس الجمعيات و الثاني يتعلق بالتجمعات العمومية و الثاني بالصحافة.
مظاهر تعثر مسلسل إقرار الحريات العامة في المغرب لا يختلف عن مثيلاتها في اغلب الدول النامية و حتى الغربية حيث تقوم الدولة على مبدأ الا تراجع للسلطة أمام الحرية و يتجلى دلك في اقبار لهذه المبادئ في المشاريع الدستورية مثل دستور 1908 الذي برزت فيه أنانية السلطان عبد الحفيظ و إضافة إلى فترة الحماية التي غابت فيها الحريات الخاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة ، أما بعد الاستقلال فتميزت هذه الفترة بإذخال تعديلات ضيقت من نطاق الحرية مقابل توسيع من صلاحيات الادارة إضافة إلى الفراغ السياسي في فترة الاستثناء ما بين 1965 و 1970 التي تميزت بالتوثر بين نظام الحاكم و المعارضة وما تبعه من اعتقالات و تقييد و انتهاك الحريات من أبرز هذه التعديلات ، ظهير الحريات ما بين 1959 و 1960 و تعديل 1970 الذي قيد تأسيس الجمعيات و عقد التجمعات حيث كان للدولة الحق في حلها بمقتضى مرسوم اسنادا الى السلطة التقديرية الواسعة للإدارة , تعديل المسطرة الجنائية لسنة 1974 الذي يعطي للسلطات الادارية التذخل في العديد من المناسبات بغير مبرر و قد نعث بالقانون الجنائي للحريات العامة .
هذا كله لا ينفي بعض مظاهر التقدم في مجال الحريات العامة في المغرب اذ أنه بمجرد اقرارها فإن ذلك يعني تقيد السلطة كما أن تشبت الدولة بهذه الحريات و الحقوق كما هو متعارف عليه دوليا لا يمكن إلا أن يعكس خطا تقدميا.
لوضع مفهوم للجمعية يجب أولا التمييز بين الجمعية المغربية و الجمعية الأجنبية
الجمعية المغربية: ھي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينھم.
ولكي تتميز الجمعية بالصفة السياسية لا بد أن تمارس نشاطا سياسيا والذي يحدده ظھير تنظييم الجمعيات.
الجمعية الاجنبية : التي عرفها الفصل 21 من ظهير الجمعية الاجنبية بأنها تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء ، الهيآت التي لها مميزات جمعية و لها مقر في الخارج ولها مسيرون آجانب أو نصف اعضاءها اجانب ، أو يدريها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.
أنواع الجمعيات :
جمعيات الخواص : تؤسس طبقا لقانون الاتزامات و العقود و هي معترف لها بصبغة المصلحة العمومية و تخضع لبعض الإجراء ات .
الجمعيات الاتحادية و الجماعات : هي مجرد تجميع للجمعيات من اجل تنسيق و تكثيف الجهود للرفع من المردودية و حسن أداء لتصبح قوة اقتراحية ضاغطة أكثر.
جمعيات ذات الصبغة السياسية التي تمارس نشاطا سياسيا و الحقيقة أن كل الجمعيات تمارس النشاط السياسي بشكل او بآخر ، وذلك لكون الجمعيات تختبئ وراء النشاط الثقافي و الحقوقي مثلا لتمارس السياسية و هذه الجمعيات تنطبق عليها مقتضيات الاحزاب السياسية .
الجمعيات الاجنبية التي تتوفر على مميزات الجمعية المغربية ولكن مقرها في الخارج أو نصف أعضاءها أجانب ، أو يسيرها أجانب .
خطوات تأسيس الجمعيات :
أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس جمعية من الجمعيات هي بناء التصور العام ووضع القوانين الاساسية ، الا انه لا بد التمييز بين خطوات التأسيس و شروط التأسيس .
اولا: خطوات التأسيس
تكوين لجنة تحضيرية تكون مهمتها الاساسية وضع الخطوط العريضة للتصور العام و دواعي التأسيس ، توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية ، إعداد مشروع التصور العام للجمعية ، اعداد مشروع القانون الاساسي ، تحديد لائحة الاعضاء المؤسسين ، الاتصال بالاشخاص المقترحين و مناقشة الفكرة و دواعت التأسيس و طلب الموافقة المبدئية على الاقتراح ، تحديد موعد الجمع العام ، إخبار السلطات المحلية بتاريخ ومكان إنعقاد الجمع العام التأسيسي ، توجيه دعوة للأشخاص المؤسسين مرفقة بالوثائق الضرورية ، انعقاد الجمع العام التأسيسي .
- شروط التأسيس
يجب التمييز بون شرط تأسيس الجمعيات المغريبة و شرط تأسيس الجمعيات الأجنبية ، وكي تكون بداية تأسيس الجمعية بداية سليمة لا بد أن نقوم بالإجراء ات التالية :
تقديم تصريح مسبق و ذلك إلى مقر السلطة الإدارية المحية مباشرة أو بواسطة عون قضائي ثم توجه نسخة منه و نسخا من الوثائق إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية التي تقع الجمعية تحت نفوذها
مضمون التصريح يحمل إسم الجمعية ، أهذافها ، الاسماء الشخصية و جنسية وسن و تاريخ ومكان الازدياد إضافة إلى محل سكنى أعضاء المكتب المسير كما يجب أن يتضمن الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ، صور بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة إذا كان هناك اجانب ، الخطوط العريضة لمحضر الجمع العام التأسيسي ، إمضاء صاحب الطلب على التصريح و يشهد على صحة البيانات و الوثائق المرفقة مع أداء حق التنبر.
وعند استفاء التصريح للاجال القانونية السابقة الذكر يسلم الوصل النهائي وجوبا ذاخل آجل اقصاه 60 يوم و الذا لم يسلم خلال هذا الاجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها طبقا لما هو مسطر في قوانينها الذاخلية.
الشروط الخاصة بالجمعية الاجنبية :
يخضع تأسيس الجمعيات الأجنبية لرقابة السلطات العمومية حيث تتولى هذه الأخيرة جمع المعلومات حول الجمعية و قد تعترض الحكومة على تأسيسها أو تطلب تعديل قوانينها أو إدارتها , عموما فإنه إضافة الى الشروط المتطلبة لتأسيس الجمعية التي اشترطت في نظام التأسيس فالتاريخ الذي يجب أن ينتظره مؤسسو الجمعية لتصبح جمعيتهم قانونية هو 3 أشهر وليس شهران و لا تصبح قانونية إلا بعد استفاء نفس مسطرة التصريح و مرور 3 أشهر .
حقوق و واجبات الجمعيات ما لها و ما عليها :
الحقوق المعترف بها للجمعيات :
للجمعية أهداف مسطرة في قانونها الاساسي و لكي تحققها و تنجزها خول لها القانون مجموعة من الحقوق وقد ذكرنا بعضها فالحقوق التي يخولها التصريح كالترافع أمام المحاكم و الاقتناء ات و التملك و التصرف في واجبات الإنخراط و الإعانات العمومية والمساعدة التي يتلقاها و التداول في القضايا التي تدافع عنها من خلال اجتماعات أعضاءها في الاماكن و المقرات المعتمدة لهذا الغرض وذلك طبقا لما هو مقرر في مادة 6 من ظهير الجمعيات المعدل سنة 2002 .
وقبل تديل الفصل 6 كان يحرم الجمعيات من الإعانات العمومية و كان يحدد إنخراط الاعضاء في 240 درهم كحد اقصى مما كان يحرم الجمعيات من كثير من الموارد و ذلك قبل أن يت توسيع هذه المواد للرفع من امكانية المالية للجمعيات في القانون المطبق حاليا و الذي تم بإيعاز من حكومة التناوب الاولى بالنص على الإشتراكات الي جانب الانخراطات بدون تحديد سقف لها .
الحقوق المعترف بها للجمعيات ذات النفع العام
كل الجمعيات غير التي لها صفة سياسية و التي تؤسس طبقا لما سبق ذكره يمكن أن يتعرف لها بصفة المنفعة العامة و ذلك بمرسوم رئيس الحكومة .
يجوز لها التملك في حقوق ما يسمح لها مرسوم الاعتراف من اموال و منقولات و عقارات و لتحقيق أهذافها و مشاريعها كما يمكن أن تحصل على الهبات و الوصايا و التماس الاحسان العمومي ، فهذه الصفة تفتح للجمعية امكانية توسيع مواردها و مصادرها المالية إضافة إلى الاعفاء الضريبي و لكن ضمن دفتر محاسبي سنوي تمسكه لمدة 5 سنوات يضبط علاقاتها المالية و الادارية و هذه عرضة للمساءلة القضائية و سحب صفة المنفعة منها.
مسؤوليات الجمعيات : الواجبات و الجزاء ات
تتمثل في إحترام القوانين المنظمة لها و لأنشطتها و كدا إحترام القوانين المعمول بها بوجه عام
الالتزامات المالية للجمعيات : يجب على الجمعيات التي تحصل على إعانات من الدولة أن تقدم ميزانياتها و حساباتهم للوزارات كما يجب على الجمعيات التي تحصل على اعانات من جمعيات أجنبية أن تصرح بذلك للامانة العامة للحكومة ذاخل اجل 30 يوم من حصولها على المساعة والا تم حلها .
الجزاء ات الزجرية : تتعرض الجمعية للحل اذا كان غرضها غير مشروع يخل بالقانون و الاداب العامة ، او يمس بالدين الاسامي ، أو بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي أو تدعو الى التمييز ، كما يعاقب المسيرون المخلون بالفصل الخامس أو السادس بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم و تضاعف في حالة تكرار المخالفة ، و تتعرض نفس الاطراف المسيرة الى العقوبة الحبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنتين وغرامة ما بين 1200 و 50000 أو بإحداهما فقط في حالة التحريض على ارتكاب الجنح بالخطاب او النداء او كانت شعارات معلقة أو منشورات.
حرية التعبير من خلال تنظيم التجمعات العمومية :
الاجتماعات العمومية هي حرية مضمونة بالدستور و التي تنص عليها من خلال حرية الاجتماع و معناه كل جمع مؤقت مدبر متاح للعموم و تدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول اعمال محدد من قبل
شروط و إجراءات عقد الإجماع العمومي : سنميز بين الاجتماعات التي لا تحتاج لتصريح و التي لا بد من تصريح .
الاجتماعات المرهونة بتصريح : يهم الامر هنا كل اجتماع مدبر متاح للعموم و الذي يكون بهذف دراسة مسألة معينة إذ لا بد من تصريح مسبق و يتم اداعه لدى الجهات الادارية المحلية و يتضمن اليوم و الساعة و المكان و موضوع الاجتماع و توقيع من طرف 3 أشخاص مع ذكر أسمائهم و صفتهم و تقديم نسخ من بطائقهم الوطنية و كل تصريح كامل يعطى عنه وصل و ينعقد الاجتماع بعد 23 ساعة من ايداع التصريح أو 48 ساعة من الارسال المضمون.
الاجتماع المعفي من التصريح : يهم الامر الجمعيات و الهيآت الرسمية و المؤسسات الخيرية ... لأنها اجتماعاتها تتميز بالاستمرارية .
عموما يجب ان يتم تحديد المكان و ساعة الاجتماع حيث لا يجوز عقد الاجتماع العمومي في الطريق العام و أن لا تمتد الي ما بعد 12 ليلا ، حفاظا على النظام العام بكل مدلولاته و من أجل هذا يعمل المنظمون و السلطات المعنية على مراقبة و منع كل من يحمل السلاح او أدوات خطيرة من الدخول الى مكان الاجتماع ، و مراقبة الادارة تتجلى في الموظف الدي تعينه الجهة التي تلقت التصريح لحضور الاجتماع و مراقبة الاجهزة الامنية خارج مكان الاجتماع لحماية النظام العام ، و يترتب عن مخالفة الضوابط القانونية عقوبات حبسية و غرامات مالية تتراوح بين 2000 و 10000 درهم و حبس شهر و شهرين او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
التجمعات بالطرق العمومية و التجمهرات :
المظاهرات : تتم في الطرق العمومية للتعبير عن موقف بحمل الشعارات و الافتات او ترديد هتافات و المظاهرات تحمل مخاطر عفوية على النظام العام كالميل نحو استعمال العنف ضد الافراد و الممتلكات ، لذلك تدخل المشرع لتنظيمها تنص الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المنظم للتجمعات العمومية انه " لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية الا للاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية ، و التي قدمت لهذا الغرض تصريح سابق "
هذا التصريح يسلم الى السلطة الادارية المحلية في ظرف ثلاثة ايام كاملة على الاقل و 15 يوم على الاكثر قبل تاريخ المظاهرة ، تسلم الادارة وصلا بإيداع التصريح ، يتضمن التصريح الاسماء الشخصية و العائلية للمنظمين وكذا أرقام بطاقتهم الوطنية ، يوقع عليها ثلاثة افراد منهم، يكون محل سكناه في المنطقة التي تجرى فيها المظاهرة و يبين في التصريح الغاية من المظاهرة و المكان و التاريخ و الساعة و كذا الطرق المنوي المرور منها .
كما أن للسلطات منع المظاهرة بقرار يبلغ للموقعين على التصريح اذا رأت أنها ستمس بالنظام العام؛ بمعنى آخر التصريح وحده لا يكفي للقيام بها فالمظاهرة تتطلب نوعا من التعاون بين المنظمين و السلطات الادارية في مجال التنظيم و المحافظة على النظام العام .
ان قانون المظاهرة جاء خاليا من أي اشارة الى امكانية الطعن في قرار المنع كما ان القضاء الادراي قد لا يستطيع تقدير الظروف التي اتخد فيها قرار المنع ، لكن مفهوم دولة الحق و القانون تستوجب اعطاء فرصة للطعن في القرارات الادارية المشوبة بالتعسف في استعمال السلطة .
عقوبة مخالفة قوانين المظاهرة :
ان كل محاولة للتظليل و المغالطة قد يرد في تصريح غير صحيح او استدعاء للمشاركة في المظاهرة بعد منعها تعرض صاحبها لعقوبات تترواح بين 1200 و 5000 درهم و الحبس ما بين شهر و ستة اشهر ، كما يعاقب بحبس بين شهر و ستة اشهر و غرامة 2000 و 8000 درهم و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في مظاهرة حاملا سلاح ظاهر او خفي ، وتكون العقوبة أشد في حالة التكرار قد تصل الى حد المنع من الاقامة .
تعريف التجمهر : هو تجمع تلقائي لا يعتبر من الحريات العامة كما أنه ليس ممنوعا مبدئيا الا اذا كان عنيفا و مسلحا ، او عندما يرفض المشاركون التفرق بعد توجيه الإندار اليهم .
أشكال التجمهر
المسلح : يكون عندما يحمل شخص أسلحة ظاهرة او خفية ، في هذه الحالة تتوجه السلطات الامنية الى عين المكان تعلن وجودها بواستة مكبر للصوت تم توجه الامر للمتجمهرين بالإنصراف و تتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 .
اذا لم يستجب المتجمهرون للإنذار الاول اوجب على ممثل القوة العمومية بتوجيه اندار 2 و 3 مع الالتزام بختم هذا الاخير بعبارة سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة و في حالة ابداء امتناع يقع التفريق بالقوة ، وإذا انفض التجمھر بعد توجيه إنذار له ولم يستعمل أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة وإذا وقع التجمهر ليلا كانت العقوبة مشددة وإذا لم يتم التفريق إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاھا 5سنوات ويمكن في الحالتين المنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانته.
ـ التجمهر غير المسلح: مباح إلى حين رفض المتجمهرين التفرقة بعد الإنذارات 3 مع إعطاء مهلة بين كل إنذار. الانصراف قبل الإنذار الأول لا يرتب أية عقوبة أما الانسحاب بعد توجيه الإنذار 3 فيه عقوبة تتراوح بين شهر و 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين1200 درھم و 5000 درھم أو بإحداھما.
عموما يجب على الدولة احترام إجراءات استعمال القوة احتراما للحريات والحقوق واحترام لمبدأ دولة الحق والقانون .
آليات حماية الحريات العامة ان الاعتراف بالحريات العامة في قوانين الدولة مسألة أساسية لأنها تعطي الشرعية لها و تعطي لأصحابه الحق في ممارستها في العلن لكن هذا الاعتراف لا يكفي اذ لا بد من توفير حماية كافية وضمانات عملية هذه الضمانات ما هو سياسي ، وما هو قانوني .
الضمانات الاسياسية
اولا : دولة الحق و القانون : خضوع الدولة لسيادة القانون ، اي ان شرعية نظام الحكم من خلال الشريعية الدستورية اي مقيد بأحكام الدستور الضامن للحريات.
الديموقراطية : كوسيلة تهذف الى ادخال الحرية في العلاقات السياسية المختلفة ، كما يجب التطبيق السليم للديموقراطية يتطلب عدة شروط : من خلال فصل السلط ، التعددية الحزبية و الانتخابات الحرة و النزيهة ، وجود معارضة قادرة على توجيه انتقادات للأغلبية الحاكمة دون تضييق ، حرية المواطنين في المشاركة السياسية وممارسة حقه في التعبير.
الاحزاب السياسية كضمانة للحريات : اي مجموعة من الاشخاص يعتنقون نفس العقيدة السياسية و يدافعون عنها و يسعون للسلطة ، و هي تمثل همزة وصل بين السلطة و المجتمع المدنو ، كما انها وسيلة للتوازن السياسي و منع الاستبداد .
فصل السلط : كمبدأ لصيانة الحرية ، ومنع الاستبداد من خلال فصل كل سلطة على حدى مع امكانية مراقبة كل سلطة لأخرى سلطة توقف سلطة أخرى.
الضمانات القضائية : تتجلى في تأمين العدالة بين المواطنين بينهم و بين الادارة و ذالك من خلال مراقبة دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية إضافة إلى حماية الحريات العامة من تعسف المشرع و تعسف الادارة .
حماية الحريات العامة من تعسف المشرع بمعناه الضيق : مراقبة دستورية القوانين و مدى موافقة القوانين العادية و النصوص الدستورية .
حماية الحريات من تجاوز الادارة : المراقبة القضائية لأعمال الإدارة و ضمان عدم انتهاك لحريات المواطنين .
طبيعة القضاء المكلف بحماية الحريات العامة من تعسف الإدارة في المغرب : تم إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 تخص في البث في طلبات الطعن في قرارات الادارية ، و دعوى التعويض عن الاضرار
الضمانات غير قضائية : تختلف من دولة لأخرى حسب مدى الديموقراطية فيها ، و من أهم تجلياتها المراجعة الإستعطافية و هي عبارة عن طلب تظلم من الشخص المتضرر الى المعني بالامر لإعادة النظر في القرار الصادر في حقه ، ثم المراجعة الرئاسية التسلسلية و هي عبارة عن طلب من الشخص المتضرر يقدم للرئيس ضد المرؤوسين وذلك للنظر في القرار المطعون فيه و في كلا الحالتن لا بد من الإدلاء بالاسباب القانونية و الوقائع لكي يتم الاخد بها.
الضمانات الخاصة الرسمية : كديوان المظالم حسب تسميته الجديدة " الوسيط " هذه المؤسسة تشكل وسيلة ضغط فعالة على الادارة من خلال تقديم تقارير سنوية للبرلمان و يوزع على جميع المحاكم و المرافق الحكومية .
ضمانات شعبية و مبادرات خاصة من اجل تفعيل الحريات العامة : المجتمع المدني كالجمعيات الحقوقية اضافة لدور الصحافة و الاعلان المهم في تعبئة الرأي العام و تداعيات الإحتجاجات و المظاهرات و التجمعات في الاماكن العمومية .
النظام القانوني للحريات العامة : يتجلى النظام القانوني للحريات العامة في تنظيم ممارسة الحرية لكن لما كانت الحريات أنواع فإنه يصعب إجراء تنظيم مسبق لكل ما قد يمارسه المجتمع من حريات لأنه يصعب وضع تصور شامل لمختلف الانشطة البشرية خاصة عندما يتعلق الامر بممارسة مؤقتة أما بالنسبة للحريات التي يتطلب ممارستها الاستمرارية و الثبات كالجمعيات و الاحزاب و المنظمات و الهيئات فإنه عادة ما يتدخل القانون لتنظيمها و يشكل التنظيم وقائي : التصريح او الترخيص المسبق حسب الحالات و الاجراء ات الزجرية.
الاتفاقية الاوربية و الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان
الاتفاقية الاوربية : ايمانا منهم بتقارب الحضاري و الميراث المشترك التاريخي و الثقافي و سيادة القانون ، و المصير المشترك تم التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 1950 و ذخلت حيز التنفيد سنة 1953 ، شملت عدة حقوق مثل الحق في الحياة و الامن ، الاعتراف بالخصوصية الفردية و الفكر و العقيدة و نجد أن مجمل الحقوق مستمدة من أفكار الفلاسفة و المنظرين السابقين ، إضافة إلى التأثر بمبادئ الثورة الفرنسية .
الجديد في الاتفاقية تم التنصيص على بعض الاجهزة لحماية حقوق الانسان خلافا للاعلان العالمي لحقوق الانسان و هي :
اللجنة الاوربية لحقوق الانسان : مهمتها تلقي الشكاوى التي تطال حرية الانسان و حقوقه خاصة في الدول الاعضاء ثم يقوم هذا الجهاز بعرضها على أنظار المحكمة الاروبية لحقوق الانسان.
المحكمة الاوربية لحقوق الانسان : تتكون من عدة قضاة ينظرون في القضايا المرفوعة اليهم بعد محاولات فشل اللجنة و أحكامها نهائية و ملزمة ثم ترسل الى لجنة الوزراء قصد التنفيد.
لجنة الوزراء : جهاز سياسي مهمته اختيار أعضاء اللجنة و مهمته النظر في خرق الاتفاقية .
الامين العام للمجلس الاوربي : جهاز إضافي مهمته مساعدة المجلس الاوربي في أداء وظيفته .
الاتفاقية الامريكية : تم التوقيع عليها سنة 1969 و ذخلت حيز التنفيد سنة 1978 اكدت على احترام الحرية الشخصية و العدالة الاجتماعية و احترام حقوق الانسان كما نصت على مجموعة من الحريات مثل المشاركة السياسية في المناصب العامة و غيرها و قد أنشأت كذلك لجان للمحافظة على هذه الحريات أهمها اللجنة الامريكية لحقوق الانسان و المحكمة الامريكية لحقوق الانسان.
الحريات العامة من خلال بعض مؤسسات الدولة غير الرسمية :
منظمة العفو الدولية و الحريات العامة : أسست سنة 1961 في لندن و تنشط في أزيد من 40 دولة و العالم مهمتها الدفاع عن السجناء السياسيين و سجناء الرأي و المعتقد يناضل من أجل الغاء عقوبة الاعدام و العقوبات الوحشية و المهينة لحقوق الانسان و لها سلطة معنوية و أدبية من خلال تعبئة الرأي العالمي بالمؤتمرات و المنشورات و البايانات و التقارير السنوية .
المنظمة الدولية للحقوقيين أو اللجنة الدولية للحقوقيين : تأسست سنة 1952 دورها إرساء مبادئ العدالة والمساواة و حماية حريات الانسان إحتراما للقانون و المشروعية و تمارس سلطتها من خلال الاستشارات التي تقدمها للهيئات الدولية إضافة الى هذه المظمة هناك العديد من الاتفاقيات المكملة لما سبق مثل : تلك المتعلقة بحماية فئات و منع الابادة الجماعية و الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز العرقي زد على دلك الاتفاقيات الاقليمية كإعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام ثم الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادق عليه مجلس جامعة الدول العربية سنة 1994 و الذي يدعو إلى انتخاب لجنة خبراء حقوقيين من اجل إحالة جميع التقارير عليها.
ما قبل الحماية
لم تعرف الاوساط السياسية في هذه المرحلة جدلية السلطة و الحرية كون التنظيم المجتمعي في تلك الفترة يقوم على الجماعة و القبلية و تحكمه الاعراف و التقالييد .
في بداية القرن 20 علت بعض الاصوات ذاخل النخب المغربية من أجل بناء نظام دستوري بمؤسس للحريات و كان أبرزها مشروع دستور علي زنبير لسنة 1904 ثم مشروع دستور 1908 الدي طالب بملكية دستورية و تضمن ثلات ابواب من بينها باب لحقوق المواطنين و واجباتهم : الحريات العامة في العمل و القول ،تأمين المواطنين على حريتهم الشخصية ، كحرمة المسكن و حرية الاقامة و منع التعذيب و عدم مشروعية كل عقوبة لا يقرها القانون ، و جعل عقوبة الاعدام و العقوبات الشاقة من اختصاص منتدى الشورى ، كما تضمن المشروع المساواة في الحصول على الوظيفة ، و إلزامية التعليم الابتدائي و إحترام حق الملكية .
لم ترى هذه المشاريع النور بسبب العداء الخفي و مقاومة هذه المشاريع من طرف السلطان عبد الحفيظ و حقق المستعمر أطماعه بإخضاع المغرب للحماية.
فترة الحماية
المطالبة بإستقلال الدولة كان لصيقا بالمطالبة بالحرية ، حرية الدولة و الافراد من المستعمر الفرنسي ، تمحورت المطالبة بالإصلاح في إطار الحماية حول برنامج المطالب الذي تمخض عن كثلة العمل الوطني سنة 1934 و تم تقديم عريضة للملك و الاقامة العامة تتضمن جملة من الحريات ، كوضع حد للتمييز العنصري ، و تكوين كجمعيات و الحق في التظاهر و الصحافة و حرية العمل السياسي و منع الاعتقالات.
بالرغم من إصدار ظهائر خاصة ظهير 1936 بشأن تنظيم المظاهرات الا ان سلطات الاستعمار منعت المغاربة من ممارسة هذه الحقوق.
بعد الاستقلال :
يعتبر العهد الملكي الصادر سنة 1958 لبنته الاولى لإقرار مبدأ الحريات العامة حيث سعى لتحرير المواطن بعد تحرير البلاد و هذا المبدأ سيذكر في" القانون الاساسي للملكة الصادر 1961" و احتفظت به جميع الدساتير المغربية ، و بصدور قانون الحريات العامة في نفس السنة أي 58 الذي تضمن 3 ظهائر الاول يتعلق بتأسيس الجمعيات و الثاني يتعلق بالتجمعات العمومية و الثاني بالصحافة.
مظاهر تعثر مسلسل إقرار الحريات العامة في المغرب لا يختلف عن مثيلاتها في اغلب الدول النامية و حتى الغربية حيث تقوم الدولة على مبدأ الا تراجع للسلطة أمام الحرية و يتجلى دلك في اقبار لهذه المبادئ في المشاريع الدستورية مثل دستور 1908 الذي برزت فيه أنانية السلطان عبد الحفيظ و إضافة إلى فترة الحماية التي غابت فيها الحريات الخاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة ، أما بعد الاستقلال فتميزت هذه الفترة بإذخال تعديلات ضيقت من نطاق الحرية مقابل توسيع من صلاحيات الادارة إضافة إلى الفراغ السياسي في فترة الاستثناء ما بين 1965 و 1970 التي تميزت بالتوثر بين نظام الحاكم و المعارضة وما تبعه من اعتقالات و تقييد و انتهاك الحريات من أبرز هذه التعديلات ، ظهير الحريات ما بين 1959 و 1960 و تعديل 1970 الذي قيد تأسيس الجمعيات و عقد التجمعات حيث كان للدولة الحق في حلها بمقتضى مرسوم اسنادا الى السلطة التقديرية الواسعة للإدارة , تعديل المسطرة الجنائية لسنة 1974 الذي يعطي للسلطات الادارية التذخل في العديد من المناسبات بغير مبرر و قد نعث بالقانون الجنائي للحريات العامة .
هذا كله لا ينفي بعض مظاهر التقدم في مجال الحريات العامة في المغرب اذ أنه بمجرد اقرارها فإن ذلك يعني تقيد السلطة كما أن تشبت الدولة بهذه الحريات و الحقوق كما هو متعارف عليه دوليا لا يمكن إلا أن يعكس خطا تقدميا.
لوضع مفهوم للجمعية يجب أولا التمييز بين الجمعية المغربية و الجمعية الأجنبية
الجمعية المغربية: ھي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينھم.
ولكي تتميز الجمعية بالصفة السياسية لا بد أن تمارس نشاطا سياسيا والذي يحدده ظھير تنظييم الجمعيات.
الجمعية الاجنبية : التي عرفها الفصل 21 من ظهير الجمعية الاجنبية بأنها تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء ، الهيآت التي لها مميزات جمعية و لها مقر في الخارج ولها مسيرون آجانب أو نصف اعضاءها اجانب ، أو يدريها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.
أنواع الجمعيات :
جمعيات الخواص : تؤسس طبقا لقانون الاتزامات و العقود و هي معترف لها بصبغة المصلحة العمومية و تخضع لبعض الإجراء ات .
الجمعيات الاتحادية و الجماعات : هي مجرد تجميع للجمعيات من اجل تنسيق و تكثيف الجهود للرفع من المردودية و حسن أداء لتصبح قوة اقتراحية ضاغطة أكثر.
جمعيات ذات الصبغة السياسية التي تمارس نشاطا سياسيا و الحقيقة أن كل الجمعيات تمارس النشاط السياسي بشكل او بآخر ، وذلك لكون الجمعيات تختبئ وراء النشاط الثقافي و الحقوقي مثلا لتمارس السياسية و هذه الجمعيات تنطبق عليها مقتضيات الاحزاب السياسية .
الجمعيات الاجنبية التي تتوفر على مميزات الجمعية المغربية ولكن مقرها في الخارج أو نصف أعضاءها أجانب ، أو يسيرها أجانب .
خطوات تأسيس الجمعيات :
أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس جمعية من الجمعيات هي بناء التصور العام ووضع القوانين الاساسية ، الا انه لا بد التمييز بين خطوات التأسيس و شروط التأسيس .
اولا: خطوات التأسيس
تكوين لجنة تحضيرية تكون مهمتها الاساسية وضع الخطوط العريضة للتصور العام و دواعي التأسيس ، توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية ، إعداد مشروع التصور العام للجمعية ، اعداد مشروع القانون الاساسي ، تحديد لائحة الاعضاء المؤسسين ، الاتصال بالاشخاص المقترحين و مناقشة الفكرة و دواعت التأسيس و طلب الموافقة المبدئية على الاقتراح ، تحديد موعد الجمع العام ، إخبار السلطات المحلية بتاريخ ومكان إنعقاد الجمع العام التأسيسي ، توجيه دعوة للأشخاص المؤسسين مرفقة بالوثائق الضرورية ، انعقاد الجمع العام التأسيسي .
- شروط التأسيس
يجب التمييز بون شرط تأسيس الجمعيات المغريبة و شرط تأسيس الجمعيات الأجنبية ، وكي تكون بداية تأسيس الجمعية بداية سليمة لا بد أن نقوم بالإجراء ات التالية :
تقديم تصريح مسبق و ذلك إلى مقر السلطة الإدارية المحية مباشرة أو بواسطة عون قضائي ثم توجه نسخة منه و نسخا من الوثائق إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية التي تقع الجمعية تحت نفوذها
مضمون التصريح يحمل إسم الجمعية ، أهذافها ، الاسماء الشخصية و جنسية وسن و تاريخ ومكان الازدياد إضافة إلى محل سكنى أعضاء المكتب المسير كما يجب أن يتضمن الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ، صور بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة إذا كان هناك اجانب ، الخطوط العريضة لمحضر الجمع العام التأسيسي ، إمضاء صاحب الطلب على التصريح و يشهد على صحة البيانات و الوثائق المرفقة مع أداء حق التنبر.
وعند استفاء التصريح للاجال القانونية السابقة الذكر يسلم الوصل النهائي وجوبا ذاخل آجل اقصاه 60 يوم و الذا لم يسلم خلال هذا الاجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها طبقا لما هو مسطر في قوانينها الذاخلية.
الشروط الخاصة بالجمعية الاجنبية :
يخضع تأسيس الجمعيات الأجنبية لرقابة السلطات العمومية حيث تتولى هذه الأخيرة جمع المعلومات حول الجمعية و قد تعترض الحكومة على تأسيسها أو تطلب تعديل قوانينها أو إدارتها , عموما فإنه إضافة الى الشروط المتطلبة لتأسيس الجمعية التي اشترطت في نظام التأسيس فالتاريخ الذي يجب أن ينتظره مؤسسو الجمعية لتصبح جمعيتهم قانونية هو 3 أشهر وليس شهران و لا تصبح قانونية إلا بعد استفاء نفس مسطرة التصريح و مرور 3 أشهر .
حقوق و واجبات الجمعيات ما لها و ما عليها :
الحقوق المعترف بها للجمعيات :
للجمعية أهداف مسطرة في قانونها الاساسي و لكي تحققها و تنجزها خول لها القانون مجموعة من الحقوق وقد ذكرنا بعضها فالحقوق التي يخولها التصريح كالترافع أمام المحاكم و الاقتناء ات و التملك و التصرف في واجبات الإنخراط و الإعانات العمومية والمساعدة التي يتلقاها و التداول في القضايا التي تدافع عنها من خلال اجتماعات أعضاءها في الاماكن و المقرات المعتمدة لهذا الغرض وذلك طبقا لما هو مقرر في مادة 6 من ظهير الجمعيات المعدل سنة 2002 .
وقبل تديل الفصل 6 كان يحرم الجمعيات من الإعانات العمومية و كان يحدد إنخراط الاعضاء في 240 درهم كحد اقصى مما كان يحرم الجمعيات من كثير من الموارد و ذلك قبل أن يت توسيع هذه المواد للرفع من امكانية المالية للجمعيات في القانون المطبق حاليا و الذي تم بإيعاز من حكومة التناوب الاولى بالنص على الإشتراكات الي جانب الانخراطات بدون تحديد سقف لها .
الحقوق المعترف بها للجمعيات ذات النفع العام
كل الجمعيات غير التي لها صفة سياسية و التي تؤسس طبقا لما سبق ذكره يمكن أن يتعرف لها بصفة المنفعة العامة و ذلك بمرسوم رئيس الحكومة .
يجوز لها التملك في حقوق ما يسمح لها مرسوم الاعتراف من اموال و منقولات و عقارات و لتحقيق أهذافها و مشاريعها كما يمكن أن تحصل على الهبات و الوصايا و التماس الاحسان العمومي ، فهذه الصفة تفتح للجمعية امكانية توسيع مواردها و مصادرها المالية إضافة إلى الاعفاء الضريبي و لكن ضمن دفتر محاسبي سنوي تمسكه لمدة 5 سنوات يضبط علاقاتها المالية و الادارية و هذه عرضة للمساءلة القضائية و سحب صفة المنفعة منها.
مسؤوليات الجمعيات : الواجبات و الجزاء ات
تتمثل في إحترام القوانين المنظمة لها و لأنشطتها و كدا إحترام القوانين المعمول بها بوجه عام
الالتزامات المالية للجمعيات : يجب على الجمعيات التي تحصل على إعانات من الدولة أن تقدم ميزانياتها و حساباتهم للوزارات كما يجب على الجمعيات التي تحصل على اعانات من جمعيات أجنبية أن تصرح بذلك للامانة العامة للحكومة ذاخل اجل 30 يوم من حصولها على المساعة والا تم حلها .
الجزاء ات الزجرية : تتعرض الجمعية للحل اذا كان غرضها غير مشروع يخل بالقانون و الاداب العامة ، او يمس بالدين الاسامي ، أو بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي أو تدعو الى التمييز ، كما يعاقب المسيرون المخلون بالفصل الخامس أو السادس بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم و تضاعف في حالة تكرار المخالفة ، و تتعرض نفس الاطراف المسيرة الى العقوبة الحبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنتين وغرامة ما بين 1200 و 50000 أو بإحداهما فقط في حالة التحريض على ارتكاب الجنح بالخطاب او النداء او كانت شعارات معلقة أو منشورات.
حرية التعبير من خلال تنظيم التجمعات العمومية :
الاجتماعات العمومية هي حرية مضمونة بالدستور و التي تنص عليها من خلال حرية الاجتماع و معناه كل جمع مؤقت مدبر متاح للعموم و تدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول اعمال محدد من قبل
شروط و إجراءات عقد الإجماع العمومي : سنميز بين الاجتماعات التي لا تحتاج لتصريح و التي لا بد من تصريح .
الاجتماعات المرهونة بتصريح : يهم الامر هنا كل اجتماع مدبر متاح للعموم و الذي يكون بهذف دراسة مسألة معينة إذ لا بد من تصريح مسبق و يتم اداعه لدى الجهات الادارية المحلية و يتضمن اليوم و الساعة و المكان و موضوع الاجتماع و توقيع من طرف 3 أشخاص مع ذكر أسمائهم و صفتهم و تقديم نسخ من بطائقهم الوطنية و كل تصريح كامل يعطى عنه وصل و ينعقد الاجتماع بعد 23 ساعة من ايداع التصريح أو 48 ساعة من الارسال المضمون.
الاجتماع المعفي من التصريح : يهم الامر الجمعيات و الهيآت الرسمية و المؤسسات الخيرية ... لأنها اجتماعاتها تتميز بالاستمرارية .
عموما يجب ان يتم تحديد المكان و ساعة الاجتماع حيث لا يجوز عقد الاجتماع العمومي في الطريق العام و أن لا تمتد الي ما بعد 12 ليلا ، حفاظا على النظام العام بكل مدلولاته و من أجل هذا يعمل المنظمون و السلطات المعنية على مراقبة و منع كل من يحمل السلاح او أدوات خطيرة من الدخول الى مكان الاجتماع ، و مراقبة الادارة تتجلى في الموظف الدي تعينه الجهة التي تلقت التصريح لحضور الاجتماع و مراقبة الاجهزة الامنية خارج مكان الاجتماع لحماية النظام العام ، و يترتب عن مخالفة الضوابط القانونية عقوبات حبسية و غرامات مالية تتراوح بين 2000 و 10000 درهم و حبس شهر و شهرين او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
التجمعات بالطرق العمومية و التجمهرات :
المظاهرات : تتم في الطرق العمومية للتعبير عن موقف بحمل الشعارات و الافتات او ترديد هتافات و المظاهرات تحمل مخاطر عفوية على النظام العام كالميل نحو استعمال العنف ضد الافراد و الممتلكات ، لذلك تدخل المشرع لتنظيمها تنص الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المنظم للتجمعات العمومية انه " لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية الا للاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية ، و التي قدمت لهذا الغرض تصريح سابق "
هذا التصريح يسلم الى السلطة الادارية المحلية في ظرف ثلاثة ايام كاملة على الاقل و 15 يوم على الاكثر قبل تاريخ المظاهرة ، تسلم الادارة وصلا بإيداع التصريح ، يتضمن التصريح الاسماء الشخصية و العائلية للمنظمين وكذا أرقام بطاقتهم الوطنية ، يوقع عليها ثلاثة افراد منهم، يكون محل سكناه في المنطقة التي تجرى فيها المظاهرة و يبين في التصريح الغاية من المظاهرة و المكان و التاريخ و الساعة و كذا الطرق المنوي المرور منها .
كما أن للسلطات منع المظاهرة بقرار يبلغ للموقعين على التصريح اذا رأت أنها ستمس بالنظام العام؛ بمعنى آخر التصريح وحده لا يكفي للقيام بها فالمظاهرة تتطلب نوعا من التعاون بين المنظمين و السلطات الادارية في مجال التنظيم و المحافظة على النظام العام .
ان قانون المظاهرة جاء خاليا من أي اشارة الى امكانية الطعن في قرار المنع كما ان القضاء الادراي قد لا يستطيع تقدير الظروف التي اتخد فيها قرار المنع ، لكن مفهوم دولة الحق و القانون تستوجب اعطاء فرصة للطعن في القرارات الادارية المشوبة بالتعسف في استعمال السلطة .
عقوبة مخالفة قوانين المظاهرة :
ان كل محاولة للتظليل و المغالطة قد يرد في تصريح غير صحيح او استدعاء للمشاركة في المظاهرة بعد منعها تعرض صاحبها لعقوبات تترواح بين 1200 و 5000 درهم و الحبس ما بين شهر و ستة اشهر ، كما يعاقب بحبس بين شهر و ستة اشهر و غرامة 2000 و 8000 درهم و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في مظاهرة حاملا سلاح ظاهر او خفي ، وتكون العقوبة أشد في حالة التكرار قد تصل الى حد المنع من الاقامة .
تعريف التجمهر : هو تجمع تلقائي لا يعتبر من الحريات العامة كما أنه ليس ممنوعا مبدئيا الا اذا كان عنيفا و مسلحا ، او عندما يرفض المشاركون التفرق بعد توجيه الإندار اليهم .
أشكال التجمهر
المسلح : يكون عندما يحمل شخص أسلحة ظاهرة او خفية ، في هذه الحالة تتوجه السلطات الامنية الى عين المكان تعلن وجودها بواستة مكبر للصوت تم توجه الامر للمتجمهرين بالإنصراف و تتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 .
اذا لم يستجب المتجمهرون للإنذار الاول اوجب على ممثل القوة العمومية بتوجيه اندار 2 و 3 مع الالتزام بختم هذا الاخير بعبارة سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة و في حالة ابداء امتناع يقع التفريق بالقوة ، وإذا انفض التجمھر بعد توجيه إنذار له ولم يستعمل أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة وإذا وقع التجمهر ليلا كانت العقوبة مشددة وإذا لم يتم التفريق إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاھا 5سنوات ويمكن في الحالتين المنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانته.
ـ التجمهر غير المسلح: مباح إلى حين رفض المتجمهرين التفرقة بعد الإنذارات 3 مع إعطاء مهلة بين كل إنذار. الانصراف قبل الإنذار الأول لا يرتب أية عقوبة أما الانسحاب بعد توجيه الإنذار 3 فيه عقوبة تتراوح بين شهر و 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين1200 درھم و 5000 درھم أو بإحداھما.
عموما يجب على الدولة احترام إجراءات استعمال القوة احتراما للحريات والحقوق واحترام لمبدأ دولة الحق والقانون .
آليات حماية الحريات العامة ان الاعتراف بالحريات العامة في قوانين الدولة مسألة أساسية لأنها تعطي الشرعية لها و تعطي لأصحابه الحق في ممارستها في العلن لكن هذا الاعتراف لا يكفي اذ لا بد من توفير حماية كافية وضمانات عملية هذه الضمانات ما هو سياسي ، وما هو قانوني .
الضمانات الاسياسية
اولا : دولة الحق و القانون : خضوع الدولة لسيادة القانون ، اي ان شرعية نظام الحكم من خلال الشريعية الدستورية اي مقيد بأحكام الدستور الضامن للحريات.
الديموقراطية : كوسيلة تهذف الى ادخال الحرية في العلاقات السياسية المختلفة ، كما يجب التطبيق السليم للديموقراطية يتطلب عدة شروط : من خلال فصل السلط ، التعددية الحزبية و الانتخابات الحرة و النزيهة ، وجود معارضة قادرة على توجيه انتقادات للأغلبية الحاكمة دون تضييق ، حرية المواطنين في المشاركة السياسية وممارسة حقه في التعبير.
الاحزاب السياسية كضمانة للحريات : اي مجموعة من الاشخاص يعتنقون نفس العقيدة السياسية و يدافعون عنها و يسعون للسلطة ، و هي تمثل همزة وصل بين السلطة و المجتمع المدنو ، كما انها وسيلة للتوازن السياسي و منع الاستبداد .
فصل السلط : كمبدأ لصيانة الحرية ، ومنع الاستبداد من خلال فصل كل سلطة على حدى مع امكانية مراقبة كل سلطة لأخرى سلطة توقف سلطة أخرى.
الضمانات القضائية : تتجلى في تأمين العدالة بين المواطنين بينهم و بين الادارة و ذالك من خلال مراقبة دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية إضافة إلى حماية الحريات العامة من تعسف المشرع و تعسف الادارة .
حماية الحريات العامة من تعسف المشرع بمعناه الضيق : مراقبة دستورية القوانين و مدى موافقة القوانين العادية و النصوص الدستورية .
حماية الحريات من تجاوز الادارة : المراقبة القضائية لأعمال الإدارة و ضمان عدم انتهاك لحريات المواطنين .
طبيعة القضاء المكلف بحماية الحريات العامة من تعسف الإدارة في المغرب : تم إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 تخص في البث في طلبات الطعن في قرارات الادارية ، و دعوى التعويض عن الاضرار
الضمانات غير قضائية : تختلف من دولة لأخرى حسب مدى الديموقراطية فيها ، و من أهم تجلياتها المراجعة الإستعطافية و هي عبارة عن طلب تظلم من الشخص المتضرر الى المعني بالامر لإعادة النظر في القرار الصادر في حقه ، ثم المراجعة الرئاسية التسلسلية و هي عبارة عن طلب من الشخص المتضرر يقدم للرئيس ضد المرؤوسين وذلك للنظر في القرار المطعون فيه و في كلا الحالتن لا بد من الإدلاء بالاسباب القانونية و الوقائع لكي يتم الاخد بها.
الضمانات الخاصة الرسمية : كديوان المظالم حسب تسميته الجديدة " الوسيط " هذه المؤسسة تشكل وسيلة ضغط فعالة على الادارة من خلال تقديم تقارير سنوية للبرلمان و يوزع على جميع المحاكم و المرافق الحكومية .
ضمانات شعبية و مبادرات خاصة من اجل تفعيل الحريات العامة : المجتمع المدني كالجمعيات الحقوقية اضافة لدور الصحافة و الاعلان المهم في تعبئة الرأي العام و تداعيات الإحتجاجات و المظاهرات و التجمعات في الاماكن العمومية .
النظام القانوني للحريات العامة : يتجلى النظام القانوني للحريات العامة في تنظيم ممارسة الحرية لكن لما كانت الحريات أنواع فإنه يصعب إجراء تنظيم مسبق لكل ما قد يمارسه المجتمع من حريات لأنه يصعب وضع تصور شامل لمختلف الانشطة البشرية خاصة عندما يتعلق الامر بممارسة مؤقتة أما بالنسبة للحريات التي يتطلب ممارستها الاستمرارية و الثبات كالجمعيات و الاحزاب و المنظمات و الهيئات فإنه عادة ما يتدخل القانون لتنظيمها و يشكل التنظيم وقائي : التصريح او الترخيص المسبق حسب الحالات و الاجراء ات الزجرية.