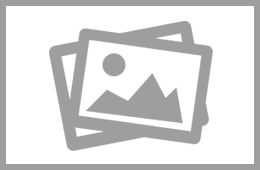لاشك أن التطورات التي لحقت الظواهر الاقتصادية الكبرى التي يعرفها العالم تفرض على الدولة خاصة السائرة في طريق النمو تحسين برامجها الاقتصادية لمواجهة التحديات الكبرى والخطيرة للعولمة بتطوير آلياتها الإنتاجية والرفع من قدراتها التنافسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تساهم سياسة المنافسة في تجسيدها والتي حددها خبراء الاقتصاد في أهداف تهم الأداء الاقتصادي للشركات والأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية وخدمة الأداء الفردي والجماعي والتوزيع غير الممركز والأمثل للأنشطة الاقتصادية وترسيخ دعائم الحرية الاقتصادية وإنعاش قواعد قانونية شفافة في عالم المقاولات والأعمال[1].
وأمام هذه التحولات لابد أن التعاملات البشرية في إطار ما يسمى بالتعاقد أو العقد الناشئ عن توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه[2]. نجد أن الضابط الحقيقي لهذه التعاملات هو العقد وأن الضابط الحقيقي لهذا العقد هو الإرادة، إلا أن هذه التحولات تركت بصماتها على هذا النظام القانوني التقليدي للعقود والتي يثبت أركانه على أساس مبدأ سلطان الإرادة التعاقدي، حيث يرجع الأصل التاريخي لهذا المبدأ إلى القانون الكنسي الذي كان يوجب الوفاء بالوعود بل ويعتبر مدنبا من نقض وعده، خاصة إذا علمنا أن الوعد كان يقترن باليمين، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا صدر تحت تأثير التدليس، وحيث كان العقد العاري (المجرد من الشكل) يكفي بذاته لترتيب الالتزام، لكن على أساس أن تكون إرادة الملزم غير معيبة ومتجهة إلى غرض مشروع، أما قبل هذه المرحلة فلم يكن هذا المبدأ معروفا، فالقانون الروماني لم يقر به في أية مرحلة من مراحل تطوره طالما كانت صحة وإلزامية الاتفاقات مرتبطة بضرورة صبها في قوالب شكلية أو بمجرد تبادل إشارات أو عبارات محددة دون اعتبار لمدى سلامة الإرادة أو حتى لعدم وجود أو عدم مشروعية سبب الالتزام وقد ظل الأمر كذلك حتى بعد ظهور بعض أنواع من العقود بحيث ظلت الشكلية فيها هي الأصل وظلت الرضائية مجرد استثناء.
وما لبث أن عاد مبدأ سلطان الإرادة إلى الانتعاش في أوائل القرن السادس عشر لتعود للاتفاقيات قوتها ولتعزز بعد ذلك مع مشارف القرن الثامن عشر حين ظهور أنصار القانون الطبيعي والمذاهب الفردية عموما، والذين نادوا بتقديس حرية الفرد وتقوية دوره في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا القانونية، وقد توج ازدهار هذا المبدأ بمبادئ الثورة الفرنسية (1789) المكرسة لحرية الفرد وما كان له من تأثير على النزعة التي هيمنت بعد ذلك على مدونة نابليون (1804) ومنها إلى التشريعات الأخرى التي استلهمت أحكامها[3].
ولاشك أن أول من رفع شعار "حرية المبادلات، حرية العقود، حرية العمل وحرية المزاحمة" هم الفيزيوقراطيون وعلى رأسهم آدام سميث الذي روج للمبدأ الشهير "دعه يعمل دعه يمر-" laisser faire laisser passer"، ولقد صدر ق.ل.ع مع دخول الحماية للمغرب سنة 1913. في وقت كانت فيه حرية الإرادة تلعب دورا مهما وكبيرا وباعتبار التطور الاقتصادي الذي عاشته أوربا آنذاك وكثرة الإنتاج وضرورة البحث عن منافذ وأسواق لترويج هذه المنتجات، فقد نتج عن كل ذلك أن عمدت سياسة الاستعمار أو نظام الحماية، إلى تطبيق مبدأ "دعه يعمل" في الداخل للوصول إلى تطبيق الشق الثاني منه وهو "دعه يمر"، أي ضرورة وجود أسواق مختلفة لترويج هذه السلع والمنتجات المتراكمة الناتجة عن مبدأ "دعه يعمل"، وهكذا كان المغرب من بين الدول التي طبق عليها المبدأ السابق، فخضع للحماية الفرنسية ومن تم طبق عليه مبدأ الحرية الاقتصادية الذي نتج عنه الحرية التعاقدية[4].
وإذا أرجعنا انتصار مبدأ سلطان الإرادة إلى عوامل اقتصادية بالأساس فهذه العوامل ذاتها بعد أن تطورت وقامت الوحدات الإنتاجية الكبيرة ونظمت طوائف العمال على إثر اختلال التوازن بين القوى الاقتصادية، مما أدى إلى انتشار روح الاشتراكية وقيامها في وجه المذاهب الفردية، هذه العوامل كان من شأنها أن تنتقص من مبدأ سلطان الإرادة، فيكون هذا المبدأ قد قام على أساس اقتصادي[5]، وانتكس متأثرا بعوامل اقتصادية اعتمدته كمطية بين ما هو اقتصادي وقانوني، أو بين رجل الاقتصاد ورجل القانون، فإذا كان الأول يحكمه عامل الربح والاحتكار والتعسف في الشروط والمنافسة، والثاني يحكمه العقد والاقتصاد معا، حيث يكون مجبرا أمامهما بوضع سياسة معينة لتوجيه الاقتصاد الوطني وفقا لمتطلبات اقتصادية وتجعل العقد يحمل أرباح اقتصادية ونفس الوقت اجتماعية، ومن خلال تفعيل الاقتصاد لكسب الرهانات الداخلية المتمثلة في الصحة، التعليم، العدل لرفع مؤشر النمو الداخلي وكسب الرهانات الخارجية المتمثلة في العولمة والتنمية .
وبهذا تصبح الدولة تحمل على عاتقها مسؤولية التوفيق بين هذه الأهداف التي أدت إلى خلق علاقة تنافسية بين القانون الاقتصادي والقانون العقدي والقانون الدولي، هذا الأخير الذي يخضع هو باستمرار لتطورات الاقتصاد أو لضغوطات دولية تفرضها عليه من أجل التدخل التشريعي لتوجيه الاقتصاد وتوجيه العقد من أجل التجاوب التفاعلي بين القانون والواقع الاقتصادي في صورة مؤسسة العقد الاقتصادي والاجتماعي.
بعدما ظهرت أنواع جديدة من العقود ليست منظمة من قبل ق.ل.ع الذي تقادم وشاخ وأصبح بذلك عاجزا عن مواكبة هذه المتغيرات، وأدى إلى عدم الفعالية تمخض عنه ما سمي "بأزمة العقد"، دفعت إلى تزايد تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العقد من خلال ظهائر خاصة من أجل تحقيق التوزان العقدي النسبي في طرفي العلاقة. لكن الإشكال المطروح كيف تعامل القانون الرسمي (الدولة) مع ثورة العقود على ق.ل.ع؟ حتى لا يطلق العنان إلى مبدأ سلطان الإرادة أو ليس في هذا ضرب لهذا المبدأ؟
ينتج عنه تساؤول حول طبيعة العلاقة التي ستربط العلاقات الاتفاقية التي يحكمها قانون العقود والميدان الاقتصادي والتي يحكمها قانون المنافسة، هل يتعلق الأمر باندماج كامل أم تعارض وتصادم؟ أو بعبارة أدق هل الأمر يتعلق بتراجع المبادئ الأساسية لقانون العقود أم بتطورها بسبب تواجد قانون المنافسة إلى جانبه؟ بمعنى آخر هل يسير العقد نحو الانهيار أم أنه مازال ثابتا بالرغم من جميع التغيرات التي لحقت التحولات التي أصيب بها ؟ وإذا كان كذلك فإلى أي حد سيبقى محافظا بمناعته أمام مقتضيات التحولات الاقتصادية.
عموما سنحاول الإجابة على هذه الإشكاليات من خلال هذه الدراسة وعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم الموضوع التالي:
- المبحث الأول: علاقة العقد بالظروف الاقتصادية
· المطلب الأول: تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد
· المطلب الثاني: تدخل الدولة لتوجيه العقد
- المبحث الثاني: مصير العقد نتيجة الظروف الاقتصادية
· المطلب الأول: ثبات العقد واندماجه أمام الظروف الاقتصادية
· المطلب الثاني: انهيار العقد وتراجعه أمام الظروف الاقتصادية.
المبحث الأول: علاقة العقد بالظروف الاقتصادية
نتج عن التقدم التكنولوجي والتقلبات الاقتصادية الكبرى مع نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين، والأزمات التي صاحبتها، وظهور الفوارق الجسيمة مع الإجحافات التي لحقت طبقات عديدة من كل المجتمعات التي تنتهج اقتصاد الليبرالي، وإلى أن ظهر تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد من أجل نمو منسجم وبالتالي رفع الحيف عن الأطراف الضعيفة والذي يتماشى والنظام الرأسمالي الذي يؤمن بضرورة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد، ولأن القانون يمكن اعتباره نظام مستقل بذاته، وذلك لأن القاعدة تتركب من عدة عناصر يعود أصل تكوينها إلى مجموعة من المصادر التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا[6]، وهذه الأخيرة التي أثارت مخاوف تقنية الغرض منها خدمة تصورات الاقتصاديين[7]، مما حدا بالدولة كذلك التدخل لتوجيه العقود لحماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة التي يحتضن كل واحد منهما لطرف الآخر بشدة، وذلك من أجل تحقيق التوازن العقدي النسبي. إن السؤال المطروح هنا كيف تدخلت الدولة لتوجيه الاقتصاد لمواكبة الاقتصاد العالمي والتنافسية الشرسة التي لا ترحم بشكل يتناغم وازدواجية قانون العقود وقانون المنافسة في العلاقات الاتفاقية في الميدان الاقتصادي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد (المطلب الأول)، ثم تدخل الدولة لتوجيه العقد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد
وكما سبق الذكر في ظل الضغوطات التنافسية الجديدة وتسريع معاملات التطوير التكنولوجي للمعدات والسلع والخدمات تصبح هناك ضرورة ملحة للبحث عن صيغ جديدة لتوسيع حيز الفضاء الاقتصادي الذي تتحرك في إطاره الوحدات الاقتصادية ويفرض خلق فضاء اقتصادي أكثر قوة وشفافية ومناعة وتنافسية، هذا التوجيه حول النظام الاقتصادي الليبرالي من منطلق يثق بالقوانين الليبرالية للسوق والمنافسة الحرة إلى اقتصاد موجه من طرف الدولة التي تتدخل مباشرة في تنظيم العقود والإنتاج وتوزيع الأموال والخدمات وضمان استقرار الأسعار، وحفظ معدل جيد لتداول عملياتها باعتبار التضخم من أعظم المشاكل التي تؤرق الاقتصاديين، هذا المشكل له ارتباط وثيق بمعدل النمو الذي تتدخل الدولة وبصفة مستمرة لتجعله منسجما مع التحولات الاقتصادية وتبعاته، والمغرب بدوره ابرم مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقية التبادل الحر مع أن التاريخ لم يثبت أن التنمية تتحقق من الخارج، على الرغم مما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيل المقاولات الوطنية والرفع من مستواها وتحيين النصوص القانونية المنظمة لها والمؤطرة لنشاطها وتقريبها من نظيراتها الأوربية، وكأداة للإنتاج والتوزيع والتشغيل وتنشيط الحركة التجارية والصناعية[8]، ولرفع من قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمار والوصول إلى منظومة الاقتصاد العالمي لأن ظاهرة العولمة الاقتصادية فرضت على الدول المتقدمة والسائرة ف طريق النمو على حد سواء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في تحرير الأسعار ورفع الحدود أمام الواردات، وتحرير الاستثمار الخارجي المباشر.
فعولمة الاقتصاد تعني اقتصاد لا يعرف الجهات والإيديولوجيات المختلفة، وإنما تعتمد مذهبا واحدا هو الليبرالية، يدعو إلى شراكة كونية يتعاقد فيها رجال المال ورجال الأعمال، وتتفاوت فيها شروط التنمية تبعا لنسبة أرباح المستثمرين في عالم كأنه قرية واحدة يحركها فكر فريد وكأن المال الموجود في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا له حق الحركة في جميع أنحاء العالم من دون حاجز خصوصا بعد تطبيق اتفاقية الكاط[9].
وإذا كان المغرب قد اختار النظام الليبرالي في مجتمع جوانب سياسية فهذا التوبة لم يبرز بصيغ اعتباطية وارتجالية وإنما جاء كاعتراف لما أصبحت تجعله المقاولة من مصالح متعددة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على المستوى الاجتماعي والدولي وهكذا ينبغي على جميع أرباب المقاولات الإسهام في الجهاد الأكبر الاقتصادي بفعالية وحماس فلا يجدر ببعض المقاولات المغربية أن تستثمر في الاعتماد على اقتصاد الريع والامتيازات والمكاسب السهلة ولا أن تضع نفسها على هامش حركة التعبئة العامة... من أجل مغرب الاقتصاد الاجتماعي
وإذا كانت الزيادة في الإنتاج وبالتالي الاستهلاك مسألة متعلقة بالسياسة الاقتصادية فإن القانون، بالمقابل هو الذي يعود إليه أمر تحديد الإطار القانوني والرفع من التنظيم الاقتصادي الملائم من خلال تنظيمها تنظيما دقيقا، لذلك يحاول أن يسير بسرعة منسجمة مع سرعة التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى كثرة التدخلات والتدابير التشريعية لدرجة أصبح المتخصصون في الميدان القانوني يصعب عليهم أن يعلموا علم اليقين بجميع القواعد وتفاصيلها المختلفة التي تتغير باستمرار.
وخلاصة ما سبق بأن كل هذه المتغيرات هي المقصود منها التحولات بمعناها الواسع والتي أثرت لا محالة في العقد بشكل جلي.
مما دفع بالدولة لتدخل من جديد لتوجيه العقود لتأكد أنها صاحبة السيادة دائما ولا تضيع هيبتها أمام التطورات الحاصلة.
المطلب الثاني: تدخل الدولة لتوجيه العقد
وكما سبق توضيح ذلك، فإن إرادة الدولة الكامنة في وضع سياسة معينة وتوجيه الاقتصاد الوطني وفقا لمتطلبات وحاجات الزمن الاقتصادي ويفرز ضرورة ملحة لتوجيه العقود له نتائج على الحرية التعاقدية بمعنى أن إرادة الأطراف هي التي تنتج العقد تحت مبدأ سلطان الإرادة كأهم مبادئ قانون الالتزامات والعقود كرسه الفصل 230 من نفس القانون، أسسه الفكر الاقتصادي في الظاهر والسياسي في الخفاء. فهذه الحرية التعاقدية التي سادت خلال القرن الثامن عشر كانت تقضي بأن كل التزام حر يعتبر عادلا، وهو ما أكده الفيزيوقراطيون، غير أننا لا نسلم بهذه الفكرة اليوم على إطلاقيتها لأن القول بغير ذلك يعني أن يبقى المشرع مكبل الأيدي ويمتنع عليه تنظيم عقد الشغل مثلا، وترك الأمر لحرية المشغل والأجير، وهذا أمر مبالغ فيه، كذلك أنه في جميع هذه الأمثلة نكون أمام اللاتوازن في العلاقة العقدية[10]، الموازي لعدالة عقدية، مما توجب معه على المشرع التدخل لحماية الطرف الضعيف في العقد أمام هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بواسطة قواعد قانونية آمرة تلزم الأطراف تحت طائلة العقوبة عند الإخلال بها. لكن أليس في هذا ضرب بمبدأ سلطان الإرادة؟ فطالما أن العقد أصبح يحمل أرباحا اقتصادية وأن العلاقة بين القانون والاقتصاد هي علاقة نفعية أكثر مما هي مسألة خدمة القانون للاقتصاد، فالتكامل بينهما ضروري لضمان الحق في التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وأمام عجز قانون الالتزامات والعقود عن احتضان جميع هذه التعاملات بفعل التحولات الاقتصادية الرأسمالية التي بدأت تضع شروطا تعسفية في العقد بحكم التفوق التقني والاقتصادي في عقود الإذعان التي أصبحت تنتشر يوما بعد يوم وبأشكال مختلفة نتيجة التطور الاقتصادي الحديث الذي اتجه إلى أسلوب الانتاج الكبير وما استتبع ذلك من قيام شركات ضخمة ومؤسسات تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة بإملاء إرادتها وشروطها المعدة مسبقا على الراغبين في التعاقد معها دون أن يملكوا منافسة هذه الشروط، لكن في الأونة الأخيرة بدأ مجال هذه العقود يطبق تدريجيا نتيجة شدة المنافسة التي ألقت بشكل شبه كلي خاصة الاحتكار فلا تكاد تجد اليوم سلعة أو خدمة محتكرة لدى منتج واحد، وذلك راجع إلى توجيه الاقتصاد نحو الأسواق العالمية في إطار ما يعرف بالتجارة الحرة أو التبادل الحر كمظهر من مظاهر العولمة، لذلك فهذه العقود بدورها في طريق الاندثار إلى جانب ذلك ظهور قطاعات اقتصادية جديدة تمخض عنها ظهور أنواع العقود والتصرفات المتطورة هدفها تسريع عملية التعاقد وربح الوقت والجهد، فقد كان لتزايد الانتاج وغزارة كمية السلع المهنية حتى التاجر، وخول هذا الأخير شراء سلع بكميات كبيرة وبيعها بموجب نماذج العقود وذلك لتفادي المساومة التي تستغرق وقتا وجهدا وهي نتيجة لحد تنظيمها والغير منظمة من قبل قانون الالتزامات والعقود تمخض عن هذا الوضع ظهور أزمة العقد، كان لزاما على المشرع التدخل من أجل التخفيف من حدة عقود الإذعان وتنظيم العقد النمطي الذي يصنع لخدمة ظاهرة اقتصادية معينة لحماية الزبون والفاعل الاقتصادي والإنعاش الاقتصادي الوطني مثل عقود الرحلة المنظمة، وعقود اتصالات المغرب، وغيرها من القعود التي تنظم مجالات مختلفة، فهذا التدخل جاء كضرورة كمحاولة الحفاظ على استقرار المعاملات بشكل جديد يتماشى وتفعيل الاقتصاد لكسب الرهانات الداخلية والخارجية.
لكن أمام هذا التدخل هل سيحتفظ العقد بنفس مفهومه الوارد في قانون الالتزامات والعقود؟ أم سيكون من الواجب عليه (المشرع) تصحيحه وفق هذه التحولات الاقتصادية؟ وإذا تم إقرار تصحيحه فهل سيتم ذلك من داخل قانون الالتزامات والعقود؟ أم من خارجه.
المبحث الثاني: مصير العقد نتيجة التحولات الاقتصادية
عمل المغرب على وضع إستراتيجية بغية تهييء الإطار القانوني لجلب الاستثمار وتمكين المقاولة الوطنية من الوسائل والآليات المحفزة عل الانخراط العملي في الإقلاع الاقتصادي كخيار في ظل انعكاسات العولمة وبروز التنافسية المحتدمة، فكانت البداية بتبني سياسة... وإخراج... ووصولا... وبقدر ما عمل المشرع على توفير القوانين المرتبطة بعالم المقاولة والشغل... لأن القانون ليس مجرد علم وحسب، وليس مجرد عمل عقلي بحت، بل هو من العلوم ذات العلاقة الوثيقة بالمجتمع، فهو يهدف إلى تحقيق مصلحة الجماعة، وينصهر في طبيعة المجتمع، ويؤثر فيه ويتأثر به، والثبات القانوني إذ كان هو السبيل لاستقرار المعاملات، فإن حياة التشريع ترتبط بانسجامه مع متطلبات التطور، فلا يجب أن يمنع عنه كل تعديل لا يكون مصدره الإرادة العقدية، طالما كان هذا التعديل أمرا لازما وضروريا لحياته. فالقاضي مهما حاول إعادة التوازن إلى العقد، فإن ذلك يبقى مجرد محاولات فاشلة في غياب تدخل تشريعي، بل إن القاضي لا يريد أن يكون كرجل اقتصاد داخل المحكمة.
وهذا راجع إلى شيخوخة قانون الالتزامات والعقود وعدم قدرته على ضبط جميع المفاهيم الاقتصادية وتنظيمها مما أثر على وضعية العقد بين الثبات والانهيار أمام موجة التغيير، فما هي إذا آثار هذه التغيرات على مصير العقد؟
المطلب الأول: ثبات العقد واندماجه أمام التطورات الاقتصادية
العقد أهم وسيلة ابتكرها الفكر القانوني لتنظيم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية[11].
وعليه فالعقد أصبح في الحياة المعاصرة يتطلب مسايرة التحولات الاقتصادية ومن تم يستدعي ذلك من المتعاقدين حسن النية في التعامل والأمانة التي تفرض على المتعاقدين الثقة في تنفيذ التزاماتها في جو يطبعه الصدق والتعاون، لأن العقد يقوم على فكرة التعاون، وبذلك يكون عهدا من جانب المدين الملزم بوفائه وتضحية من جانب الدائن، يجب أن يبذلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا يجب أن ينظر إلى الالتزام العقدي من جانب أحد المتعاقدين دون الآخر، ولعل خير مثال نقدمه بهذا الخصوص هو ما تضمنته مدونة التجارة في الكتاب الخامس المتعلق بنظام معالجة المقاولة إذ نجد أن كتلة الدائنين تتضامن وتتعاون من أجل إنقاذ المقاولة من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالمقابل خو آية حماية للدائنين لاستيفاء ديونهم؟ أم أنهم ملزمون بتقديم تنازلات وتضحيات قومية للحركة التجارية والصناعية
ولعل مكن بين أهم أنواع التقنيات والممارسات الجديدة في التعاقد نجد الشراء عن طريق التليفزيون والانترنيت والبيع بالسلف وعقد الائتمان الإيجاري والكراء المفضي إلى التملك وعقد الفرنشيز والاعتماد المستندي والبيع بالخسارة وعقد البيع المنزلي وعقود بنكية متعددة...
إضافة إلى ما سبق ما يلفت الانتباه هو أن رجال القانون عادة ما يستعملون في تحليلاتهم مصطلحات اقتصادية مثل: الاستهلاك، المنافسة، الاحتكار، حرية المبادلات، الاستثمار، الضريبة، التجارة الدولية، الربح، سعر الفائدة، الخسارة...
وقد تدخل المشرع كذلك ليضع الأساس السليم القائم على المصلحة العامة في العقود ببروز أسلوب تنميط العقود في مجموعة من الميادين مثل عقد الرحلة المنظمة، ويعتبر هذا التدخل أو هذه العقود النمطية ثورة على قانون الالتزامات والعقود، لأنها نظمت من خارجه وليس من داخله.فهي صورة لمحاولة المشرع إدماج العقد وحفظ الثبات له أمام هذه التطورات الاقتصادية.
فالقواعد العامة عجزت عجزا تاما عن احتضان العقود الجديدة ومسايرة بذلك الظاهرة الاقتصادية، وفي إطار دائما مقاربة مدى ثبات العقد نجد أنه ظهرت العقود الإلزامية المفروضة على الأطراف بقوة القانون كما هو والحال مالكم السيارة الملزم بالتأمين ضد المسؤولية التي يمكن أن تنشأ تجاه ضحاياه المحتملين، أو تلك المقتضيات التي جاء بها قانون التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي أصبحت تفرضها الظروف الحالية للتطور الذي يشهده المغرب، فهي عقود تلزم المتعاقد في إرادته التي لا تحتل سوى مكان ثانوي.
كما يعد قانون المنافسة وحرية الأسعار شاهدا آخر على هذه الهشاشة، ذلاك أنه قانون متعدد التخصصات، فهو يتضمن امتداد وتقاطع القوانين بين القانون المدني والجنائي وأخيرا القانون الإداري، وهذا الارتباط بين هذه القوانين هو ارتباط وثيق جدا يستعصي معه تصنيفه في خانة محددة لتجانسها[12]، في قالب قانون المنافسة وحرية الأسعار متوخيا من ورائه تحقيق تنافس شريف إلى جانب تعاقد قد يروم نحو الإنصاف، وكفالة سلامة الرضا وحرية الإرادة والاختيار المتبصر تفاديا للوقوع في حبائل التضليل والغش والاستغلال. وبهذا الخصوص أيضا فقد صدر مؤخرا القانون المتعلق بحماية المستهلك لتطوير الآليات التشريعية من أجل مواجهة صعوبات التحديات الاقتصادية وتأطير هذه العلاقة بين المهني والمستهلك بصورة أفضل تستجيب لسياسة الوحدة الأوربية وتساهم في تقوية السوق الداخلية وتطوير آلياتها.
ولا ننسى أن نشير أيضا أنه رغم محاولة العقد الثبات والاندماج مع هذه التطورات كما سبقت الإشارة، إلا أن هذا لا ينفي أنه لا زال عاجزا عن مواجهة ومقاربة بعض المجالات الحيوية الاقتصادية بهذا الخصوص، ويقف مكثف الأيدي حيالها، بالرغم من هذه الترسانة المتزايدة للقوانين، فلازال يشكو من الخصاص حتى يواكب الثبات والاندماج الكلي مع التحولات الاقتصادية الآنية والمستقبلية.
المطلب الثاني: انهيار العقد وتراجعه أمام التحولات الاقتصادية
هكذا وكما سبق توضيحه، فإن كل هذه المتغيرات هي المقصود منها التحولات الاقتصادية بمعناها الواسع والتي أثرت في العقد بشكل جلي، وإن كان يصعب ضبطها، ووضع تعريف أو تحديد لها، لأن أي محاولة من قبيل ذلك ستتعرض بدورها لتحول سواء في الحال أو في المستقبل، وإن كان هذا التأثير إيجابي من حيث التطورات الحاصلة في مجال العقود إلا أن هذه العقود تحمل في طياتها اختلال التوزان العقدي، إذ أصبحت التشريعات تضع قواعد آمرة منظمة لهذه العقود، بعد أن كانت تقتصر على وضع وقاعد مكملة لإرادة الأفراد فقط، وأصبح بذلك دور الإرادة في إنشاء الالتزامات وترتيب الآثار يتقلص، فتمخض الفكر الاقتصادي عن صياغته عقود نموذجية تبرم بالإذعان وهذه الأخيرة توجد عن النقيض تماما مع العقد بمفهومه التقليدي المشبع بمبدأ سلطان الإرادة لأن لا مجال فيها للتراضي ولا وجود لها يسمى تجربة التعاقد ومضمون العقد لا يعده الأطراف واحد وما على الطرف الآخر الانقياد والانضمام إلى العقد.
في هذا الإطار نذكر أن العقد هو اتجاه إرادة الأطراف إلى إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر ينصب حول إنشاء أو تعديل أو إنهاء حق، وبناء عليه يعتبر اتفاق الأطراف هو أساس تنظيم هذه العلاقة اعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين، أي أن العقد يتضمن القواعد التي يخضع لها أطرافه، ويترتب عن ذلك أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاقهم (المادة 230 ق.ل.ع.م)
من هذه الزاوية في إطار صعوبة المقاولة نلاحظ أن العقد أصبح يجسد قيمة مالية تنخرط في تقويم المقاولة مما جعل الهاجس الاقتصادي يهيمن على مستقبل العقود ضمن هذه المؤسسة وهو وضع لا بد وأن يترك بصمات واضحة على مستوى المفاهيم التقليدية للعقد.
بحيث أصبح إنهاء العقد أو مواصلته يستند إلى اعتبارات اقتصادية كسد مصلحة المقاولة والسنديك هو الذي يحدد هذه المصلحة وكذا العقود المرتبطة بالمحافظة على نشاط ومستقبل المقاولة على حساب قواعد جوهرية في نظرية العقد، مما يجعل المتعاقد الآخر يواجه بتدابير خاصة تضيع معها حقوقه
أما العقود النمطية كمولود جديد اقتحم عالم المعاملات لا يمكن إدراجه ضمن تقسيمات الأفقية للعقود، ولكنه على العكس تماما اتخذ لنفسه تقسيما مضادا تقسيمات عموديا لا يعترف بالحدود ولا ينضبط لمسلمات وعقد كهذا شأنه يجعل تعريفه أمرا صعبا، فهو ليس عقد تقليديا يمكن أن تعرفه انطلاقا من أطرافه ومحله وسببه وإنما عقد يقف مؤقتا مناقضا لكل القواعد العامة بل وحتى الخاصة أيضا ذو طبيعة تتكفل الدولة من خلال سلطتها التشريعية بتنظيمه من البداية إلى النهاية، فما مدى توفير الحماية من الشروط التعسفية في هذه العقود؟ هكذا تكون العوامل التي أدت إلى انتكاص مبدأ سلطان الإرادة هي ذاتها التي قامت عليها إلى جانب العوامل السياسية.
خلاصة القول، وكما قال بعض الفقه إننا أصبحنا أمام انهيار للعقد، وأنه لم يبق من هذا الأخير إلا الاسم فقط "أزمة العقد"، وهذا أصدق تعبير يمكن أن يطلق على الحالة التي وصل إليها هذا الأخير، فكل المحاولات التي تم نهجها في سبيل إنقاذ مؤسسة العقد من الانهيار باءت بالفشل، ولم تأتي أكلها، فلا تعديلات المتلاحقة على القوانين المدنية نجحت والاستثناءات التي تم إيرادها على المبدأ أفلحت، وانهياره يعني انهيار كافة المعاملات لذلك لم يجد هذا الفكر مرة أخرى بدا من البحث الجاد عن وسيلة أو جديد من علاقات التعاقد حكمه نظام قانوني جديد يصلح لضبطه وتنظيمه.
إذا كان من نتيجة نخلص إليها في الختام هو أن هذا الموضوع يثير جدلا عميقا وتضاربا بين المصالح الاقتصادية والمبادئ التعاقدية.
وإذا كانت العولمة أداة لتنشيط التجارة العالمية وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وخصوصا حركية رؤوس الأموال واليد العاملة في انتشار أحدث التقنيات، فهي مع ذلك لا تخلو من آثار سلبية، فإذا كانت اقتصاديات الدول المتقدمة قادرة بفضل بنيتها القوية على امتصاص الهزات الاقتصادية العنيفة وتجاوز الانعكاسات الخطيرة التي تترتب على العولمة باعتبارها في واقع الأمر حيلة اقتصادية للتمكن من فتح جميع أبواب العالم أمام منتجاتها دون أن تتمكن الحواجز الجمركية من أن تجد لها سبيلا لإيقافها أو على الأقل تقييدها، فإن الدول النامية وعلى النقيض من ذلك، لن تستطيع أن تتجاوز الآثار السلبية للعولمة بسبب بنيتها الاقتصادية الهشة، حيث لم يبق أمامها من حل سوى البحث عن الحلول الملائمة لتجاوز – أو على الأقل- تجنب الهزات العنيفة عن تطبيق نظام العولمة.
وأمام هذه التحولات الاقتصادية أدى تطور نظرية العقد إلى قيام المشرع المغربي بإعادة النظر في القواعد والقوانين المشبعة بمبدأ سلطان الإرادة والمذهب الفردي وتدل لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وتحقيق نوع من التوازن بين الأطراف، فتارة نجد في صف المكري، وتارة أخرى في صف المكتري، ولأن هذا التدخل التشريعي يبقى محدود ومحكوما بالقواعد العامة كما أنه لازال محتشما ولا يساير المستجدات في المجالات الاقتصادية، التي لا ندري ماذا تحفي وراءها في المستقبل وما ستأتي به من مفاهيم جديدة على مؤسسة العقد خاصة وأن المسيرة والحلقة الاقتصادية لا تعرف التوقف، بل هي دائما في تطور مستمر وحركة دؤوبة، فالأمر يستدعي في هذا المجال التوفيق بين اتجاهين ظاهرهما متناقض لكنهما يتكاملان في الواقع: الليبرالية في صورتها الجديدة والتوجه الاقتصادي دون ترك الأفراد يتعاقدون بحماقة بواسطة قواعد لا تترك الحرية المطلقة في صياغة العقود وفرض الشروط قواعد تحافظ على التوازن العقدي كوسيلة من أجل تحقيق غاية هي خدمة الظاهرة الاقتصادية. فالقواعد التي نتكلم عنها لا تهدف لحماية طرف معين بقدر ما تسعى لحماية الاقتصادية، فإذا تحققت هذه الحماية تحققت معها بالنتيجة حماية الطرفين في العقد.
من إنجاز الطلبة:
الزياني سميرة
أعبيد بوشرى
أجكان عائشة
التصميم
مقدمة
- المبحث الأول: علاقة العقد بالظروف الاقتصادية
· المطلب الأول: تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد
· المطلب الثاني: تدخل الدولة لتوجيه العقد
- المبحث الثاني: مصير العقد نتيجة الظروف الاقتصادية
· المطلب الأول: ثبات العقد واندماجه أمام الظروف الاقتصادية
· المطلب الثاني: انهيار العقد وتراجعه أمام الظروف الاقتصادية.
خاتمة.
لائحة المراجع
الكتب
محمد الشرقاني: النظرية العامة للالتزامات (العقد)، سنة 2004-2005،
أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر العدد السادس، السنة 2003.
حسني عبد الباسط جميعي: اثر التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية 1990/1991.
حسني عبد الباسط جميعي: اثر التكافؤ بين المتعاقدين ، دار النهضة العربية 1990/1991.
الندوات
الحسين بلحساني: قانون المنافسة وحرية الأسعار بين المؤثرات الخارجية والإكراهات الداخلية، أشغال ندوة العلاقات التجارية وتنافسية المقاولات في التشريع المغربي والمقارن بطنجة يومي 12 و13 يناير لسنة 2001.
الرسائل:
البشير دحوتي: اثر التحولات الاقتصادية على العقد رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، السنة الجامعية 2003-2004
[1]- البشير دحوتي: اثر التحولات الاقتصادية على العقد، ص 40.
[2]- محمد الشرقاني: النظرية العامة للالتزامات (العقد)، سنة 2004-2005، ص 39.
[3]- محمد الشرقاني: م.س، ص 40-41.
[4]- البشير الدحوتي: أثر التحولات الاقتصادية للعقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، السنة الجامعية 2003-2004، ص 12- 14.
[5]- البشير الدحوتي: م.س، ص 10.
[6]- البشير الدحوتي: م.س، ص 2.
[7]- نفس المرجع والصفحة.
[8]- أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر العدد السادس، السنة 2003، ص 117.
[9]- البشير الدحوتي: م.س، ص 44.
[10]- البشير الدحوتي: م.س، ص 18.
[11]- الحسين بلحساني: قانون المنافسة وحرية الاسعار بين المؤثرات الخارجية والإكراهات الداخلية، أشغال ندوة العلاقات التجارية وتنافسية المقاولات في التشريع المغربي والمقارن بطنجة يومي 12 و13 يناير لسنة 2001، ص 39-40.
[12]- حسني عبد الباسط جميعي: اثر التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية 1990/1991.