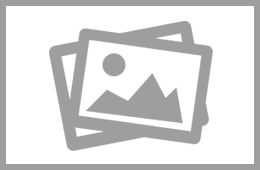صدر مؤخرا القانون رقم 33.11 والقاضي بتعديل الفصول 23، 37، 38، 39، 63 و431 من قانون المسطرة المدنية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر 2011، ونظرا لأهمية التعديلات المذكورة كان لابد من القيام بقراءة لها للوقوف عند مضامينها وفلسفتها وما إذا كانت ستحقق النتائج المتوخاة منها.
الفصل : 32 – أصبح القاضي المقرر المكلف، يطلب أيضا الإدلاء بالنسخ من المقال وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، بعد أن كان يمكنه أن يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، دون بيان أي جزاء.
الفصل : 37 – الملاحظة الأولى أن المشرع عدل الفصول المتعلقة بالتبليغ وإجراءاته، فغير الفصلين 37 و39 جزئيا وغير الفصل 38 كليا، والذي يسجل أن الفقرة الأولى من المادة 37 لم يلحقها أي تغيير لا زيادة ولا نقصانا، وبقيت كما يلي : “يوجه الاستدعاء بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو احد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد المضمون برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية”.
فالواضح أن المشرع لازال يتشبث بتعدد طرق التبليغ ويحددها في : 1- كتابة الضبط، 2-الأعوان القضائيين، 3- البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، 4- الطريقة الإدارية، ولعل مقتضيات هذه الفقرة واضحة وكافية للرد على موقف المفوضين القضائيين وبعض المسؤولين القضائيين الذين يتحدثون عن احتكار المفوض القضائي للتبليغ إذ أن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الأولى يتم نسخها لا صراحة ولا ضمنا وفي أوج هذا النقاش تدخل المشرع واقر تعديلات جوهرية على النصوص المتعلقة بالتبليغ وأبقى على الفقرة الأولى من المادة 37 وهو ما يعني أن المشرع لازال متشبعا بفكرة تعدد طرق التبليغ والاختيار بينها لان هدفه هو الوصول إلى الغاية وهي حصول التبليغ سواء كان بواسطة أعوان كتابة الضبط أو عن طريق الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية .
وبذلك يكون موقف المشرع واضح من خلال هذه التعديلات ويدحض حجة من يريد أن يمنح احتكارا للتبليغ لجهة معينة وإنكاره على الجهات الأخرى.
مع ملاحظة، انه كان حريا بالمشرع أن يعدل “لفظة” الأعوان القضائيين، ويستبدلها بالمفوضين القضائيين انسجاما مع التسمية الجديدة التي اقرها قانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
الفصل : 38 – بعد أن كان الفصل 38 يتضمن فقرات ثلاث، وبعد أن كان الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، أصبح الفصل 38 يتكون من فقرة واحدة وأصبح التبليغ للشخص نفسه أينما وجد أي بغض النظر عن محل التبليغ (المكان) أو في موطنه ولا يهم من وجد في ذلك الموطن ولا صفته، بعد أن كانت صفة القرابة أو العمالة أو السكن مع المبلغ إليه لازمة في النص القديم، وبذلك أصبح التبليغ الواقع لأي شخص وجد بالموطن الخاص بالمبلغ إليه تبليغا صحيحا ولو كان ضيفا، ولو كان صديقا ولو كان ليس من الأقارب وليس من الخدم ولا يسكن مع المبلغ إليه، وبذلك يكون المشرع قد وسع من فرص التبليغ ووضع حلا للعديد من الإشكالات التي كان يثيرها التخصص الوارد بالمادة 38 في فقرتها الأولى قبل التعديل.
المشرع وفي سبيل توسيع أماكن التبليغ ولتحقيق الهدف المتوخى وهو ضمان التبليغ والتسريع بالبت في الدعاوى، اعتبر التبليغ بمحل العمل أو أي مكان يوجد به المبلغ إليه، أي أن المشرع أضاف محل العمل وهو ما لم يكن موجودا في النص القديم كما أضاف إمكانية تبليغ المبلغ إليه فـي
أي مكان وجد فيه ولو لم يكن محل سكناه أو عمله، وبذلك فمتى بلغ الشخص شخصيا لا يلتفت إلى محل أو مكان التبليغ، فالمشرع لم يعد يحدد مكانا للتبليغ الشخصي لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا وقع فيه، بل أصبح يلتفت فقط إلى المبلغ إليه وعما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا، فمتى كان الشخص نفسه كان التبليغ صحيحا سواء تم في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر، أي يمكن مثلا تبليغه بمقهى يرتاده، أو في منزل حل به ضيفا، أو في فضاء تعود على الجلوس فيه وبالتالي لم يعد المكلف بالتبليغ ملزما ببيان مكان التبليغ ما دام أن مكان التبليغ لم يعد يحدده المشرع في مكان دون آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخص آخر فلابد من التأكد مما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله.
المشرع أضاف أيضا التبليغ بالموطن المختار، وهنا يلاحظ أن المشرع كان يعتمد الموطن المختار محلا للتبليغ لبدء احتساب اجل الطعن بالاستئناف أي لتبليغ الأحكام القضائية، إذ تنص المادة 134 من ق.م.م على ما يلي “… يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون” وأصبح المشرع يقر التبليغ بالموطن المختار حتى بالنسبة للاستدعاءات أي بالنسبة لإجراءات التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، وبذلك أصبح التبليغ صحيحا إن وقع للشخص بموطنه المختار سواء كان الأمر يتعلق بتبليغ استدعاء أو حكم أو قرار قضائي.
المشرع بمقتضى هذه المادة لم يعد يلزم بان يكون تسليم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي أو العائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، وبذلك يكون المشرع قد خفف العبء عن كتابة الضبط والتي كانت تلزم بتعبئة الاستدعاء وغلاف التبليغ وشهادة التسليم في حين الآن سيكتفى بتحرير الاستدعاء الذي يسلم للشخص وشهادة التسليم التي تعبئها الجهة المكلفة بالتبليغ قصد إرجاعها لكتابة الضبط.
إن هذا الإجراء وإن كان مستحبا عندما يتعلق الأمر بتبليغ الاستدعاءات فانه بالنسبة لتبليغ الأحكام سيطرح بعض المشاكل متى لم يسلم للمبلغ إليه غلاف التبليغ والذي يثبت به تاريخ التبليغ وبالتالي قانونية طعنه شكلا ووقوعه داخل الآجال المحددة قانونا، وهنا لن يكن أمامه إلا السعي الحصول على نظير شهادة التسليم التي ستصبح هي الحجة لإثبات تاريخ التبليغ وبالتالي أصبح المبلغ إليه يتحمل التزاما جديدا هو السعي للحصول على نسخة من شهادة التسليم متى رغب في إثبات تاريخ تبليغه.
الفصل : 39 – المشرع عدل الفقرة الثانية وبعد أن كانت تتضمن ما يلي “إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في شهادة التسليم التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” أصبح الفصل كما يلي ” إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” والملاحظ أن الفقرة تضمنت حشوا وإطنابا لا طائل منه وذلك بالإشارة إلى الموطن ومحل الإقامة رغم أن المشرع لم يستعمل محل الإقامة عند الإشارة في المادة 38 إلى أماكن التبليغ وذلك لسبب معقول وهو أن الموطن أهم من محل الإقامة ويشمله فكل محل للإقامة هو موطن للشخص وبالتالي كان يجمل به الاقتصار على الإشارة إلى الموطن للقيام بالإجراءات الجديدة التي اقرها بمقتضى التعديلات الأخيرة.
الفصل : 32 – أصبح القاضي المقرر المكلف، يطلب أيضا الإدلاء بالنسخ من المقال وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، بعد أن كان يمكنه أن يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، دون بيان أي جزاء.
الفصل : 37 – الملاحظة الأولى أن المشرع عدل الفصول المتعلقة بالتبليغ وإجراءاته، فغير الفصلين 37 و39 جزئيا وغير الفصل 38 كليا، والذي يسجل أن الفقرة الأولى من المادة 37 لم يلحقها أي تغيير لا زيادة ولا نقصانا، وبقيت كما يلي : “يوجه الاستدعاء بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو احد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد المضمون برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية”.
فالواضح أن المشرع لازال يتشبث بتعدد طرق التبليغ ويحددها في : 1- كتابة الضبط، 2-الأعوان القضائيين، 3- البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، 4- الطريقة الإدارية، ولعل مقتضيات هذه الفقرة واضحة وكافية للرد على موقف المفوضين القضائيين وبعض المسؤولين القضائيين الذين يتحدثون عن احتكار المفوض القضائي للتبليغ إذ أن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الأولى يتم نسخها لا صراحة ولا ضمنا وفي أوج هذا النقاش تدخل المشرع واقر تعديلات جوهرية على النصوص المتعلقة بالتبليغ وأبقى على الفقرة الأولى من المادة 37 وهو ما يعني أن المشرع لازال متشبعا بفكرة تعدد طرق التبليغ والاختيار بينها لان هدفه هو الوصول إلى الغاية وهي حصول التبليغ سواء كان بواسطة أعوان كتابة الضبط أو عن طريق الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية .
وبذلك يكون موقف المشرع واضح من خلال هذه التعديلات ويدحض حجة من يريد أن يمنح احتكارا للتبليغ لجهة معينة وإنكاره على الجهات الأخرى.
مع ملاحظة، انه كان حريا بالمشرع أن يعدل “لفظة” الأعوان القضائيين، ويستبدلها بالمفوضين القضائيين انسجاما مع التسمية الجديدة التي اقرها قانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
الفصل : 38 – بعد أن كان الفصل 38 يتضمن فقرات ثلاث، وبعد أن كان الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، أصبح الفصل 38 يتكون من فقرة واحدة وأصبح التبليغ للشخص نفسه أينما وجد أي بغض النظر عن محل التبليغ (المكان) أو في موطنه ولا يهم من وجد في ذلك الموطن ولا صفته، بعد أن كانت صفة القرابة أو العمالة أو السكن مع المبلغ إليه لازمة في النص القديم، وبذلك أصبح التبليغ الواقع لأي شخص وجد بالموطن الخاص بالمبلغ إليه تبليغا صحيحا ولو كان ضيفا، ولو كان صديقا ولو كان ليس من الأقارب وليس من الخدم ولا يسكن مع المبلغ إليه، وبذلك يكون المشرع قد وسع من فرص التبليغ ووضع حلا للعديد من الإشكالات التي كان يثيرها التخصص الوارد بالمادة 38 في فقرتها الأولى قبل التعديل.
المشرع وفي سبيل توسيع أماكن التبليغ ولتحقيق الهدف المتوخى وهو ضمان التبليغ والتسريع بالبت في الدعاوى، اعتبر التبليغ بمحل العمل أو أي مكان يوجد به المبلغ إليه، أي أن المشرع أضاف محل العمل وهو ما لم يكن موجودا في النص القديم كما أضاف إمكانية تبليغ المبلغ إليه فـي
أي مكان وجد فيه ولو لم يكن محل سكناه أو عمله، وبذلك فمتى بلغ الشخص شخصيا لا يلتفت إلى محل أو مكان التبليغ، فالمشرع لم يعد يحدد مكانا للتبليغ الشخصي لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا وقع فيه، بل أصبح يلتفت فقط إلى المبلغ إليه وعما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا، فمتى كان الشخص نفسه كان التبليغ صحيحا سواء تم في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر، أي يمكن مثلا تبليغه بمقهى يرتاده، أو في منزل حل به ضيفا، أو في فضاء تعود على الجلوس فيه وبالتالي لم يعد المكلف بالتبليغ ملزما ببيان مكان التبليغ ما دام أن مكان التبليغ لم يعد يحدده المشرع في مكان دون آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخص آخر فلابد من التأكد مما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله.
المشرع أضاف أيضا التبليغ بالموطن المختار، وهنا يلاحظ أن المشرع كان يعتمد الموطن المختار محلا للتبليغ لبدء احتساب اجل الطعن بالاستئناف أي لتبليغ الأحكام القضائية، إذ تنص المادة 134 من ق.م.م على ما يلي “… يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون” وأصبح المشرع يقر التبليغ بالموطن المختار حتى بالنسبة للاستدعاءات أي بالنسبة لإجراءات التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، وبذلك أصبح التبليغ صحيحا إن وقع للشخص بموطنه المختار سواء كان الأمر يتعلق بتبليغ استدعاء أو حكم أو قرار قضائي.
المشرع بمقتضى هذه المادة لم يعد يلزم بان يكون تسليم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي أو العائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، وبذلك يكون المشرع قد خفف العبء عن كتابة الضبط والتي كانت تلزم بتعبئة الاستدعاء وغلاف التبليغ وشهادة التسليم في حين الآن سيكتفى بتحرير الاستدعاء الذي يسلم للشخص وشهادة التسليم التي تعبئها الجهة المكلفة بالتبليغ قصد إرجاعها لكتابة الضبط.
إن هذا الإجراء وإن كان مستحبا عندما يتعلق الأمر بتبليغ الاستدعاءات فانه بالنسبة لتبليغ الأحكام سيطرح بعض المشاكل متى لم يسلم للمبلغ إليه غلاف التبليغ والذي يثبت به تاريخ التبليغ وبالتالي قانونية طعنه شكلا ووقوعه داخل الآجال المحددة قانونا، وهنا لن يكن أمامه إلا السعي الحصول على نظير شهادة التسليم التي ستصبح هي الحجة لإثبات تاريخ التبليغ وبالتالي أصبح المبلغ إليه يتحمل التزاما جديدا هو السعي للحصول على نسخة من شهادة التسليم متى رغب في إثبات تاريخ تبليغه.
الفصل : 39 – المشرع عدل الفقرة الثانية وبعد أن كانت تتضمن ما يلي “إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في شهادة التسليم التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” أصبح الفصل كما يلي ” إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” والملاحظ أن الفقرة تضمنت حشوا وإطنابا لا طائل منه وذلك بالإشارة إلى الموطن ومحل الإقامة رغم أن المشرع لم يستعمل محل الإقامة عند الإشارة في المادة 38 إلى أماكن التبليغ وذلك لسبب معقول وهو أن الموطن أهم من محل الإقامة ويشمله فكل محل للإقامة هو موطن للشخص وبالتالي كان يجمل به الاقتصار على الإشارة إلى الموطن للقيام بالإجراءات الجديدة التي اقرها بمقتضى التعديلات الأخيرة.
كما أن صياغة المادة وان أصبحت تستعمل عبارة : المكلف بالتبليغ بدلا من عون كتابة الضبط لم يكن المشرع فيها موفقا لأنه أردفها بعبارة “والسلطة الإدارية” وكأن السلطة الإدارية ليست جهة مكلفة بالتبليغ وبالتالي كان يجمل بالمشرع أن ينص على انه “إذا تعذر على الجهات المكلفة بالتبليغ …” بالعموم ويتفادى التخصيص الذي لا طائل منه والذي يخلق لبسا أكثر منه توضيحا.
أصبحت الجهة المكلفة بالتبليغ والسلطة الإدارية – حسبما جاء بالفصل – ملزمة متى تعذر عليها تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته بإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية.
غير أن الفقرة المذكورة لم تنص على البيانات التي يتعين أن يتضمنها الإشعار الذي يلصق ظاهرا بمكان التبليغ، بل اكتفت بالقول “بإلصاق إشعار بذلك بموضع ظاهر بمكان التبليغ ولفظة “ذلك” تعود على تعذر التبليغ أي أن الإشعار سيكون مضمونه هو تعذر التبليغ ليس إلا وهو ما يطرح السؤال حول الهدف والمغزى من هذا الإلصاق، خاصة وان المشرع كما سنرى لم يرتب أثرا على هذا التعليق أو الإلصاق، غير أن المنطق كان يقتضي نظرا لتعدد جهات التبليغ ولتباين مستوياتها الثقافية والمعرفية والقانونية أن يتم التنصيص على البيانات التي يتعين أن يشار إليها في الإشعار الذي سيتم إلصاقه كمراجع الدعوى مثلا وتاريخ الجلسة، حتى إذا ما اطلع عليها من يهمه الأمر كان من السهولة تحقيق غاية المشرع وهي حضوره واستفساره عن الدعوى.
إن الفصل 39 كان يتضمن تسع فقرات وبقي العدد هو نفسه ولم يتم سوى تغيير الفقرة الثانية وذلك باستبدال مصطلح عون “كتابة الضبط” ب الجهة “المكلفة بالتبليغ” وإضافة إجراء إلصاق الإشعار لكن وبغض النظر عن فحوى الإشعار ما هي الآثار المترتبة عن احترامه من عدمها.
الملاحظ أولا أن المشرع أبقى على الفقرات اللاحقة للفقرة الثانية من المادة 39 وبالتالي وعند تعذر التبليغ توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وفي الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف يعين القاضي عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
وهنا يطرح التساؤل عن اثر إلصاق الإشعار، فلم يرتب عليه المشرع جزاء لا بالنسبة للجهة المكلفة بالتبليغ والتي لم تقم بإلصاق الإشعار، ولا بالنسبة لعملية التبليغ التي لا تتأثر بوقوع الإلصاق من عدمه، كما أن قيام الجهة المكلفة بالتبليغ بإجراء الإلصاق للإشعار لا يغني عن اللجوء إلى الإجراء الموالي لتعذر التبليغ وهو توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبالتالي يكون هذا الإجراء زائدا ولا يرتب أي اثر قانوني اللهم انه من الناحية الواقعية يمكن أن يؤدي لحصول الغاية التي يتوخاها المشرع وهي حضور المبلغ إليه للمحكمة ولإجراءات الدعوى وذلك يمكن أن يتحقق أن اخبر هذا الشخص أو عاين وجود إشعار ملصق بموضع ظاهر بموطنه فينتقل للمحكمة ليستفسر عن الإشعار وعن موضوعه وبالتالي يعلم بالدعوى.
بقيت الإشارة إلى أن إجراء إلصاق الإشعار لا يتصور وفق هذه الفقرة إلا بموطن الشخص أو محل إقامته أما محل العمل مثلا فلا يمكن تصور إلصاق الإشعار به لان المشرع حدد الأماكن التي يعلق بها الإشعار.
الفصل : 63 – مقتضيات المادة 63 من ق.م.م كانت تنص على ما يلي “يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ويتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة انجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفقة بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا “
وبذلك كان على الخبير القيام بالعديد من الإجراءات :
- استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة.
- تضمين الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة انجاز الخبرة.
- أن يكون الاستدعاء قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد.
- يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
وألان تم تعديل هذه المادة وأصبحت كما يلي : “يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضورهم” المشرع نص على الجزاء وهو البطلان عند عدم استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة كما أتاح للأطراف الاستعانة بأي شخص يرون فائدة في حضوره.
وهنا تطرح التساؤلات الآتية :
- ما هي شكليات الاستدعاء الذي يتعين على الخبير توجيهه للأطراف ووكلائهم؟
- هل الاستدعاء الموجه للأطراف ووكلائهم مقرون اجل معين أم انه صحيح ولو تم يوم والساعة المقررة لإجراء الخبرة؟
- وهل تم الاستغناء عن المحضر الذي يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعاتهم؟
- وهل يمكن للخبير أو طرف في الخبرة أن يرفض استعانة الطرف الآخر بشخص رأى فائدة في حضوره، أي ما هو معيار الفائدة ومن أية زاوية ينظر إليها؟
إن البيانات المتعلقة بالاستدعاء كان يتعين الإبقاء عليها إذ لا فائدة من استدعاء يتوصل به طرف أو وكيله لا يتضمن موضوع الخبرة أو ساعتها أو مكانها، كما أن الخبرة في غالب الأحيان قد تستدعي تهيئ الوثائق أو الأماكن أو موضوع الخبرة بصفة عامة ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بمنح الطرف مهلة وفرصة فاصلة بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ انجاز الخبرة وبالتالي كان يتعين الإبقاء على اجل الاستدعاء خاصة وان اجل الخمسة أيام الذي كانت تنص عليه المادة 63 ليس بالأجل الطويل أو الذي قد يضر حقوق الأطراف.
أما بالنسبة لمحضر تصريحات الأطراف فان الخبير ملزم بالنصوص المسطرية المنظمة للخبرة وكذا بالحكم التمهيدي الذي يحدد مهامه والتقيد بالنقط موضوعه وإذا كان لهذه التصريحات أهمية فان المحكمة ستحدد من بين نقط الحكم التمهيدي تكليفا بانجاز محضر للتصريحات.
وبخصوص المقتضى الجديد والقاضي بإتاحة الإمكانية للطرف للاستعانة بأي شخص يرى فائدة في حضوره فانه لن يحقق إلا نفعا ما دام أن الطرف المعني بالخبرة هو الأدرى بالسبل الكفيلـــة
بالدفاع عن موقفه وذلك بأية وسيلة بما فيها إحضار شخص يرى فائدة في حضوره مما يكون معه هذا الطرف هو الذي يحدد ما إذا كانت هناك فائدة من الاستعانة بالشخص أم لا، ولا يمكن تصور تدخل الخبير أو الخصم لمنعه من ذلك ما دامت هذه المكنة التشريعية منحت لكل من الطرفين.
الفصل : 431 من ق.م.م : تنص المادة على ما يلي : “يقدم الطلب -إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي :
1- نسخة رسمية من الحكم؛
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية”
وتمت بموجب التعديل إضافة فقرة كاملة وهي ” يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة”
إن هذا التعديل جاء لسد الطريق أمام العديد من أطراف العلاقة الزوجية الذين يباشرون طعونا شتى ضد الأحكام القضائية القاضية بمنح الصبغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية وهي طعون تعسفية خاصة وان رابطة الزوجية انحلت أصلا بحكم قضائي وفقا لقانون بلد معين، ولم يعد مطروحا انحلالها وترتيب آثار الانحلال، ولكن المطروح هو تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية بالمغرب، وهذا لا يتأتى قانونا وفقا لمقتضيات المادة 430 إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليها أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، ويتعين على المحكمة أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وان تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
ولعل هذه الأمور كلها تتحقق منها المحكمة ومتى كان هناك اعتقاد بان الحكم الأجنبي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف مثلا للنظام العام فان الجهة التي لها الحق في ذلك هي النيابة العامة التي ارتأى المشرع أن يحملها أمانة ورسالة الدفاع عن القانون وعدم المساس بالنظام العام المغربي وفي ظل إتاحة هذا الطعن للنيابة العامة. يبدو منطقيا انه لا فائدة من إتاحة الحق في هذا الطعن لطرفي ميثاق الزوجية ما دام أن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية هو مجرد حكم كاشف لانحلال ميثاق الزوجية الذي قضت به المحكمة الأجنبية وليس منشئا له..