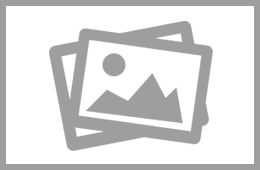التعريف بالقانون الجنائي:
-يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
-أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوة العمومية .
-أقسام القانون الجنائي:
يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد:
ا-القواعد الموضوعية: أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين:
+القانون الجنائي العام الذي يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.
+القانون الجنائي الخاص: يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها.
فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة .
ب-القواعد الشكلية:
أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية لأنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية لأنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ.
وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة بالإضافة إلى إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية .
طبيعة القانون التجاري:
يعتبر القانون الجنائي من بين فروع القوانين التي يصعب تصنيفها ضمن فروع القانون العام أو ضمن فروع القانون الخاص وفي هذا الصدد هنالك إشكالية فقهية انقسمت إلى عدة اتجاهات في تحديد طبيعته:
+اتجاه الأول: يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام نظرا لطبيعة قواعده التي تسهر على من الدولة الداخلي والخارجي والمرتبطة بحماية النظام العام حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها كما أن الجريمة في نظر هذا الاتجاه لا تشكل اعتداء على المجني عليه فحسب بل تلحق أضرار بالمجتمع بكامله .
+الاتجاه الثاني: يرى بأن القانون الجنائي يندرج ضمن فروع القانون الخاص ما دامت معظم الجرائم التي يحددها تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كما هو الشأن في جرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والإيذاء بمختلف صوره وبالتالي فهو يسهر على حماية الأفراد .
+الاتجاه الثالث: يرى بان القانون الجنائي فرع مستقل بذاته لأنه ينفرد عن غيره من فروع القوانين بتحديد موضوعي التجريم والعقاب كما أن في نطاق القانون الجنائي خطأ جسيم وفادح وبالتالي فهو يرتب جزاءات خطيرة وشديدة مقارنة بالجزاءات المترتبة عن مخالفة مقتضيات القوانين الأخرى.
علاقة القانون الجنائي بفروع القوانين الأخرى:
*فعلى مستوى القانون الخاص: تتجلى العلاقة التي يربطها القانون الجنائي بفروع القانون الخاص (ق المدني ق لتجاري ق الشغل ) في كون هذه الفروع القانونية تحدد جزاءات فير رادعة بما فيه الكفاية لاحترام مقتضيايها فادا كانت قواعد القانون المدني نتظلم حق الملكية فإن القانون الجنائي يحمي الاعتداء على هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال الاعتداء على الملكية وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعاملات التجارية فان القانون الجنائي يحرم الأفعال التي تمس بالحرية التجارية كتجريم المنافسة الغير المشروعة وإصدار شيك بدون رصيد ونفس الشيء بالنسبة لقانون الشغل حيث توجد العديد من النصوص الجنائية تحمي الطبقة الشغيلة كتجريم تشغيل القاصرين.
*فعلى مستوى القانون العام: فللقانون الجنائي علاقة بالقانون الدستوري فإذا كان هذا الأخير يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها ويبين حقوق وحريات المواطنين فان القانون الجنائي يحرم الاعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس كما انه يجرم الأفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها لدستور حرية التجول حرية الرأي والتعبير .
وللقانون الجنائي أيضا صلة وثيقة بالقانون الإداري وهي جزاءات تشبه إلى حد ما الجزاءات الجنائية غير أنها تبقى جزاءات تأديبية ذات طبيعة معنوية كتوبيخ أندار أو مهنية كوقف الترقية وتخفيض الرتبة .
-مفهوم الجريمة:
-الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون أم لا.
-أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي:
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
-أما التعريف الفقهي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي".
أركان الجريمة:
يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي:
-1 الركن القانوني:
ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات.
*مضمون مبدأ شرعية التجريم والعقاب
هذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وهو يعني أن إي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون الجنائي على تجريمه وحدد له عقابا على المخالف وأصل هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية قوله "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" .
ولأهمية هذا المبدأ فقد كرسه المشرع الجنائي المغربي في المادة الثالثة من القانون الجنائي "لايسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
ويقضي مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي بأن تكون قواعد القانون الجنائي من مستوى القانون أي أن تصدر عن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بمقتضى 45 من الدستور المغربي وهو ما يؤكده الفصل 46 من الدستور الذي ينص صراحة في فقرته الثالثة على أن القانون يختص في "تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها المسطرة الجنائية" .
*الغاية من هذا المبدأ
الغاية من هذا المبدأ هي حماية الفرد من المشرع ومن القاضي فبمقتضى هذا المبدأ يتحتم على المشرع أن يحدد أفعال الإنسان التي يعتبرها جرائم والعقوبات المقررة لها فيكون الفرد بذلك على بنية من التصرفات التي يعاقب عليها القانون فيجتنبها ويسلم من العقاب .
وتظهر الغاية من المبدأ في حماية الفرد من القاضي وذلك بالحد من سلطته التحكمية في الميدان الجنائي فلا يكمن للقاضي أن يجرم أفعالا لم يجرمها القانون ولا يمكنه أن يعاقب بعقوبات لم يحددها القانون كذلك .
كما يرفع عن الأفراد ظلم السلطة التنفيذية التي لا يمكنها أن تعاقب عن أي فعل كان إلا بالعقوبة المحددة وبالضمانات التي قررها القانون.
*النتائج العامة المترتبة على المبدأ
يترتب على مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي ضرورة التقيد بثلاثة قواعد أساسية هما:
الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي:
مقتضى هذا المبدأ أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط وبعبارة أخرى فإن قواعد القانون الجنائي لا تطبق على الأفعال التي ترتكب قبل الشروع في تطبيق القانون الذي ينص على تجريمها وبناءا على ذلك تلتزم المحكمة بتطبيق القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة لا القانون النافذ وقت المحاكمة وهذا المبدأ يطبق فقط على قواعد الموضوع دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .
*الاستثناء الواردة على المبدأ
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية
-القانون الاصلح للمتهم: هذا الاستثناء الهام من مبدأ "عدم رجعية القواعد الجنائية" كرسه المشرع المغربي في المادة 6 من القانون الجنائي التي جاء فيها "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم" فإذا كان القانون الجديد هو الاصلح فن القاضي يطبقه على تلك الجريمة ولو انها ارتكبت قبل سريان مفعوله.
ولتطبيق هذا الاستثناء لابد من توفر شرطين :
ش1- يلزم ان يكون النص الجنائي الجديد اصلح للمتهم من القديم:
قد يتدخل المشرع المغربي بطرق مختلفة ليجعل من القانون الجديد قانونا اصلح كأن يزيل الصفة الاجرامية عن فعل ما وأن ينزل به من درجة جنائية الى درجة جنحة وقد يعمد المشرع كذلك الى تخفيض عقوبة او تعويض عقوبة بعقوبة اخرى اقل شدة او تخفغيض مبلغ الغرامة وفي كل هذه الاحوال فإن القانون الجديد يطبق بأثر رجعي .
ش2-يلزم ألا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الجريمة المرتكبة حتى يطبق عليها القانون الاصلح والمقصود بالحكم النهائي هو الذي لا يكون قابلا لأي طعن عاديا كان ام استثنائيا .
وعلة هذا الاستثناء ان المشرع عندما يستبدل عقوبة اشد بعقوبة اخف او يقرر محو الجريمة او تغيير شروط التجريم فمعناه انه ادرك قساوة المقتضيات وعدم ملاءمتها لظروف الجتمع ولا مصلحة من الاستمرار في تطبيقها.
-التدابير الوقائية:
اذا كان القانون قد منع تطبيق العقوبه التي يصد عنها قانون جديد بأتر رجعي على افعال ارتكبت في ظل قانون قديم ف4 ما لم تمن اصلح للمتهم ف6 فإنه على العكس من ذلك قد سمح بتطبيق التدابير الوقائية ياثر فوري ف8 من قج . وعلة هذا الاستثناء ان التدابير الوقائية لل تعد عقابا عن افعال وقعت وإنما هي مقررة لحماية المجتمع من الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المتهم وتهذف اساسا الى اصلاحه باعادة ادماجه في المجتمع وتهذيبه.
-القوانين المفسرة :
يعمد المشرع المغربي في بعض الاحيان الى اصدار قوانين قديمة وتسمى قوانين مفسرة لذلك يجب تطبيقها بأثر رجعي على الحالات المعروضة على المحاكم والمطبق بشأنها النص الاصلي ما لم تكن هذه الحالات قد فصل فيها بحكم نهائي.
الفقرة التانية: قاعدة اقليمية القوانين الجنائية:
يقصد بهذا المبدأ ان قانون الدولة هو الذي يطبق على كل الوقائع والافعال الاجرامية التي تقع داخلها وعلى كل الافراد المقيمين بها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطينها او اجانب كما انه وفقا لهذا المبدأ فإن قانون الدولة لا يسري على مواطنبها الذين يوجدون خارج اقليمها لأنه سيصطدم بسيادة دولة اخرى.
الاسثتناءات الواردة على المبدأ:
هناك استثناءات ادخلها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على مبدأ الاقليمية ومن اهمها:
-الاخد بقواعد القانون الدولي العام الخاصة بالحصانة الدبلوماسية التي تقضي بتمتيع ممثلي الدولة الاجنبية المعتمدين رسميا بالمغرب بحصانة تجعلهم لا يخضعون للقانون المغربي بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها فوق اقليمية ويخضعون لقوانين دولهم .
-حالة ارتكاب جرائم خارج اقليم الدولة اذا كان فيها مساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي كإرتكاب جناية حما السلاح ضد المغرب اوتزييف نقود او اوزاق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية حيث يمتد اليها القانون المغربي حتى ولو ارتكبت خارج اقليم الدولة .